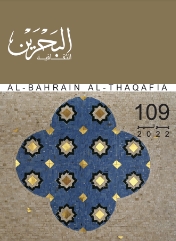ملاقف الهواء” وعـبـقـريـة الـتـبـريـد فـي الـبـيـت الـخـلـيـجـي
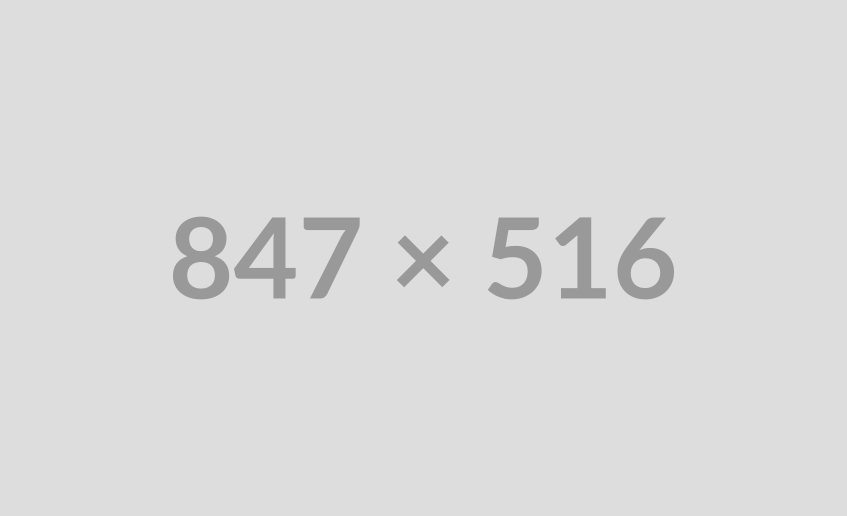
العمارة لغة الحضارة
“ملاقف الهواء” وعـبـقـريـة الـتـبـريـد فـي الـبـيـت الـخـلـيـجـي
حسني عبدالحافظ *
الإنسان بفطرته هو ابن بيئته؛ يسعى دائمــًا إلى التعايش معها، وإيجاد حلول مُناسبة لمشاكلها. ويُمكن إدراك ذلك –بجلاء– من خلال طريقة تفكيره في تصميم وبناء مسكنه، حيث تتباين مساكن البشر بتباين البيئات التي يعيشون فيها. وفي منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية –التي يتسم مناخها على وجه العموم بالجفاف والحرارة الشديدة– سعى السُكَّان عبر التاريخ إلى التفكير في حلول من شأنها تبريد الهواء داخل مساكنهم، وبالفِعل نجحوا إلى حد كبير في تصميم ما يُعرف بالعمارة السالبة، أو عمارة المناخ الحيوي architecture bio climate، التي تتميَّز بتوافقها مع البيئة، إلى حد الوصول إلى المُستوى السلبي في استهلاك الطاقة. وتعدّ “ملاقف الهواء”، التي انتشرت في كثير من العمائر التقليدية بالخليج وشبه الجزيرة العربية، من أهم الحلول العبقرية للتبريد والتهوية الطبيعية.
إن التهوية الطبيعية للمباني، في أبسط تعريف لها، “هي عملية استبدال الهواء الداخلي المُستَخدَم، بهواء نقي من الخارج، بواسطة الوسائل الطبيعية فقط”. ومُنذ القِدم، ظهرت النماذج الأولى من “ملاقف الهواء”، في بعض مباني الفراعنة، حيث ثمة دلائل أثرية تُفضي إلى أن فِكرة سحب الهواء البارد إلى أسفل، ليدخل حُجرات المبنى، كانت موجودة في عمائر ومقابر، تعود إلى أكثر من ألفين ومئة سنة قبل الميلاد. كما اكتُشِفت نماذج مُماثلة من المباني المُبرَّدة، بواسطة “ملاقف الهواء”، في حضارة ما بين النهرين، كما هو الحال في التجاويف الموجودة بقاعة العرش بقصر بابل. كما عثر على رسومات جدارية في أطلال تدمر والحيرة في الشام، وسبأ وحضرموت في اليمن، تؤكِّد على أن “ملاقف الهواء” كانت تُستَخدَم في عمائر هذه الحضارات.
لوحة الفنّان راشد سوار ،مملكة البحرين
وفي ظِل الحضارة الإسلامية، شهدت “ملاقف الهواء“ مزيداً من التطوُّر والتنوُّع، وأُدخِلت عليها بعض التقنيات غير المسبوقة، التي تزيد من فاعليتها في التبريد والتهوية داخل المبنى، ومن هذه التقنيات: أحواض الماء، التي يتناثر منها الرذاذ، ليزيد من برودة الهواء. وتُشير المصادر التأريخية، أن المُسلمين الأوائل ابتكروا ما يُعرف بـ”الباذهنج“، الذي أشار إليه أحمد بن محمد الخفاجي، في كتابه الموسوم “شفاء العليل”، قائلاً: “هو المَنفَذ الذي يجيء منه النسيم العليل”. وكان مُدير دار الكُتب المصرية قد أرشدنا إلى مخطوطة على درجة كبيرة من الأهمية، تتعلَّق بالتأريخ لهذا العمل الهندسي المعماري، عنوانها “تُحفة الأحباب في نصب الباذهنج والمِحراب”، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن رجب بن طغيا المجدي، المشهور بابن المجدي (ت 850م)، وجدنا فيها الشيء الكثير عن تفاصيل هذا الابتكار، وكيف تطوَّرت وتباينت أنواعه، خِلال عهود الخلافة الإسلامية. لقد ذَكَر عِدة طُرق لكيفية تصميمه، وهندسة بنائه، وأشار إلى أن اختلاف أشكاله يعود بالأساس إلى المواد المحليِّة المُتاحة، التي تُستَخدَم في بنائه، وكذا الظروف المناخية السائدة، وبخاصة ما يتعلَّق منها بمطالع هبوب الرياح، وقد وجدنا في مخطوطة هامة أُخرى، عنوانها “الإعلان بأحكام البيان”، منسوبة إلى ابن الرامي، بعض المعلومات المُهمَّة حول الباذهنج، وأهميته البيئية والصحية، ومن الفقرات التي استوقفتنا في المخطوطة: “إن الباذهنجات هي عناصر التهوية، التي انتشر استخدامها في العمائر الإسلامية، وزادت الحاجة إليها، في العمائر التي تُحيط بالمباني من أكثر جهاتها، وتفتقر واجهتها المُطلَّة على الطريق، عن تزويدها بالهواء اللازم، ولا سيما إذا كانت الوِحدة التي تحتاج إلى التهوية، من الوحدات التي تزدحم غالباً بالأفراد، كقاعة استقبال في دار، أو إيوان للصلاة، أو مجلس دروس العلم في مسجد، أو مدرسة، أو خانقاه، حيث يكون اللجوء إلى الباذهنج لعدم إمكان عمل نوافذ لهذه الوحدات، في تِلك المنشآت، لغرض التهوية، بسبب مجاورة المباني الأُخرى، وتجنُّب فتح نوافذ من شأنها التسبب في ضرر الكشف”.
وقد نال الباذهنج من أشعار العرب الكثير من الثناء والمديح، باعتباره جالب النسيم العليل. ومن بين الشعراء الذين هاموا في هواء الباذهنج: الشاعر مهيار الديلمي، وشهاب الدين بن أبي حجلة، وابن سناء المُلك، وبرهان الدين القيراطي. وكان غير واحد من أطباء العرب، من أمثال الرازي، وابن سينا، وابن النفيس، قد نصحوا بأن يكون الباذهنج من أساسيات تشييد المباني، في البيئات الجافة والحارة، وأشاروا إلى أهمية اختيار موضعه من البناء بعِناية، بحيث يكون جالباً فِعلياً للهواء النقي، وليس مُجرّد واجهة جمالية فقط.
الرواشين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
ملاقف الهواء” في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية
ومُنذ وقت مُبكِّر من تاريخ الحضارة العربية، عَرَفت منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية طرائق ووسائل مُتعددة لتبريد المباني، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نظام الرواشين، الذي انتشر في العديد من المباني الخليجية، ومازالت آثاره ظاهرة للعيان في بعض المباني التقليدية بمدينة جدَّة، على ساحل البحر الأحمر، وكذا في الهفوف، والطائف في المملكة العربية السعودية، والمنامة والمحرق في مملكة البحرين، وفي بعض بنايات صلالة وظفار في سلطنة عمان. وهو نظام الكُتل والفراغات في تشييد الجُدران، باستخدام مواد بناء محليِّة. وقد ثبتت أهمية هذا النظام –رغم بساطته– في الحِماية من الإشعاع الشمسي، والحِفاظ على برودة المبنى من الداخل. وقد عُرِف هذا النظام، في كثير من الأبنية بالكويت، وفي بعض المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية. كما أن من وسائل التهوية والتبريد، في المنزل الخليجي التقليدي أيضاً، ما يُعرف بالدّريشة، وهي فتحات في الجُدران تُفتَح على بطن الحوش (داخل البناء، وليس خارجه)، ولها ضلفتان من الخشب، وعادة يكون ارتفاعها على مُستوى النظر. كما عُرِفت المناور، كوسيلة إضاءة وتهوية، وإخراج الدُّخان الناتج عن تحميص القهوة، في الوجار (الموقد). ويلعب الفِناء الداخلي دوراً مُهمّاً كعُنصر من عناصر التبريد والتهوية، إلى جانب عناصر أُخرى، كالتظليل والتَّشجير.
ملقف الهواء المركزي وأنواعه
ويُعد البادجير، ملقف الهواء المركزي الأكثر أهميّة في تبريد المبنى الخليجي التقليدي، وهو امتداد لفِكرة الباذهنج، التي عُرِفت قديماً، وسبقت الإشارة إليها. ومن الأسماء الأخرى المعروفة للبادجير، في منطقة الخليج العربي: “البارجيل“، و”بُرج الهواء”، و”ملقط الهواء”، وفي شرق المملكة العربية السعودية، وبالخصوص في منطقة الأحساء، يُعرف باسم “البادجين“، بينما يُعرَف في مملكة البحرين، باسم “البادكِير“، وتتعدد الأسماء، إلاَّ أنه يظل في النهاية ملقفاً مركزياً للهواء، وظيفته الرئيسة تبريد الهواء، ومن حيث موضعه من المبنى، فهو يُصنَّف إلى نوعين:
ــ ملقف السطح:
وهو بُرج هوائي، يرتفع فوق سطح المبنى، منه الأُحادي الاتجاه، الذي تُصمم نوافذه في اتجاه واحد، وهو الاتجاه الذي تأتي منه الرياح السائدة في المنطقة. ومنه الملقف الذي تُفتَح نوافذه على أربع جهات، ومن ثم يُمكنه اقتناص الهواء من أي اتجاه.
ــ ملقف الحائط:
وهو يُصمم كجُزء من الجُدران والحوائط، ويتباين ارتفاعه وشكله واتجاهات فتحاته، بحيث يكون مُناسبـاً للحالة المناخية السائدة في المنطقة. وفِكرته –بالأساس– تعتمد على تأثير ضغط الرياح على الأسطح الكبيرة لحوائط الغُرف، وفي كثير من الأحيان يظهر على هيئة كوات مُجوَّفة أفقية، تقع غالباً في مُنتصف ارتفاع الجدار الخارجي، وفي قاع الكوّة ثمة مصراع للتحكُّم في فتحاته، أو إغلاقها، حيث يتجمَّع الهواء ذو الضغط العالي، المار على سطح الجدار الخارجي للغُرفة المواجهة للريح، ويندفع من الكوّات إلى الداخل، ليتجدد الهواء، وتصل النسمات المُنعشة إلى الجالسين. وينتمي إلى فئة “ملاقف الهواء“ الحائطية، ما يُعرف بالبدقش، الذي هو عبارة عن “مقطع بالجُزء العلوي من الحائط، راداً للخلف، تاركاً فجوة لمرور الهواء إلى داخل الغُرف”.
ومن حيث التَّكوين، تُصنف “ملاقف الهواء“ إلى ثلاثة أشكال:
- الملاقف ذات المسقط المُربَّع، التي يتساوى فيها عدد الفتحات في كُل الجهات.
- الملاقف ذات المسقط المُستطيل، التي يزيد فيها عدد الفتحات من جهة مُعيَّنة، عن الجهات الأُخرى، وبالطبع فإن الجهة التي تتركَّز فيها الفتحات، تكون باتجاه الرياح الرئيسية، أو جهة البحر.
- الملاقف ذات المسقط الدائري، وهي قليلة، بل بالأحرى نادرة، وتكون على هيئة أسطوانية مُفرغة، تُشبه –إلى حد كبير– هيئة المئذنة.
صورة مشروع قلب الشارقة ، الامارات
نماذج وشواهد
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر دول الخليج وشبه الجزيرة العربية التي تزخر بالبراجيل، حيث تُشاهد وهي تعلو الكثير من البيوت التقليدية. وقد لاحظنا أن بعض البيوت –خاصة الكبيرة منها– تحتوي على أكثر من بارجيل. وبحسب المصادر التأريخية، فإن هذه البراجيل الإماراتية، يعود البدء بإنشائها إلى العام 1903م، عندما وصلت طوائف تُجَّار وصُنَّاع القواسم وبني ياس، من “لنجة“، واستقر كثير منهم في دبي، خاصة بمنطقة الفهيدي، وأقاموا البيوت التي تعلوها هذه البراجيل، ومازال بعضها قائماً إلى الآن، في الأحياء القديمة، مثل البستكية، والشندغة، وجلها مُشيَّد بالطوب والحجر، ويصل ارتفاعها فوق المباني، إلى بضعة أمتار، وتتسم بالثبات والقوَّة والمتانة، وهي بمثابة وحدات تبريد مركزية. واللافت للانتباه، وجود أكثر من طِراز في المنطقة الواحدة، خُذ مثالاً: في حي البستكية، ثمة طرازان شائعان: الأوَّل وهو مفتوح من جهاته الأربع، والثاني وهو المفتوح من جهة واحدة فقط، وكلاهما يظهر على هيئة مُكعَّب، وموضعه فوق السطح، وعادة يرتكز على دعامة مركزية. ومُعظم هذه البراجيل يُقاس ارتفاعها من مُستوى سطح الأرض بنحو خمسة عشر متراً، وهو الارتفاع المُناسب في هذه المنطقة، حيث تكون سُرعة الرياح أعلى بمرَّة ونصف المرّة على الأقل، من سُرعتها بالقُرب من السطح.
وليست دبي الإمارة الوحيدة التي تتميز بيوتها القديمة بالبراجيل، إذ نجدها أيضاً في إمارة عجمان، التي فيها اثنان من البراجيل، يُصنَّفان بأنهما من أقدم البراجيل في منطقة الخليج قاطبة، يعلوان حِصن عجمان، الذي قام الشيخ راشد بن حميد النعيمي بترميمه، واتخذه سكناً له، مع إطلالة القرن التاسع عشر، ويظهر كُل منهما على هيئة مُربَّع، طول كل ضِلع من أضلاعه أربعة أمتار، وبكُل ضِلع ثلاث فتحات مُستطيلة معقودة، بحيث تسمح بدخول أكبر قدر من الهواء، ويعلو كُل منهما رفٌّ، ينتهي من أعلى بصف من الشـُرفات الزخرفية.
وفي البيوت القديمة بإمارة الشارقة، ثمة غير طراز من البراجيل، منها الطراز الأسطواني النادر، الذي سبقت الإشارة إليه، والموجود في بيت السيد إبراهيم محمد المدفع، في منطقة صلاح الدين، بالقُرب من سوق العرصة، والذي جرى ترميمه عام 1996م، بتوجيهات من صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. ومن أبرز مواصفات هذا البارجيل الأسطواني، أنه محمول على ثمانية أعمدة، لها تيجان كاسيَّة، تحمِل قُبَّة بصلية الشكل ترتكِز على أفريزَين مزخرفين بزخارف هندسية مُفرغة، وينتهي بخوذة القبة من أعلى، بحلية زخرفية تُشبه الوردة، ويرتفع البارجيل من سقف السطح وحتى خوذة القبة، إلى نحو ثمانية أمتار، وقُطره نحو أربعة أمتار. كما توجد بعض البيوت القديمة، التي تتزين بالبراجيل، في إمارة أم القيوين.
وفي مملكة البحرين، ثمة نماذج وشواهد بارزة، تؤكِّد مدى ما وصلت إليه هندسة البراجيل من تقدُّم، سواء في التصميم، أو خامات ومواد البناء المُستخدَمة، أو طريقة التنفيذ. وتُعد البلدة القديمة، بمدينة المحرق، التي كانت العاصمة السابقة للبحرين، من أكثر الأماكن التي ترتفع فوق بيوتها التقليدية البراجيل، أو كما يُسميها أهل البحرين “البادكِير“. ومن أهم هذه البيوت وأشهرها، بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ذو الأفنية الأربعة، والأبواب الخشبية المنحوتة على نحو رائع، والمزين بألواح جصية مثقوبة. ويأتي موضع برج الهواء المركزي، إلى الجهة الغربية من جناح العائلة، وتحديداً “فوق الحُجرة الكبيرة المُسماة “لقعود”، وهو برج مُستطيل الشكل، مفتوح من جهاته الأربع، وبفضل تصميمه الرائع، فإنه يتلقَّف نسمات الهواء النقية، ويُنزلها بانسيابية عبر الفتحات، لتنتشر في أركان الحُجرة الكبيرة، التي تتصِل بها، وتُفتَح عليها، حُجرة كبيرة أُخرى، تُشكِّلان معاً قاعة فسيحة، تُستَخدَم للجلوس والاجتماعات.

بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ،مدينة المحرّق، مملكة البحرين
والحقيقة أن برج الهواء المركزي هذا، ليس وحده الذي يُضفي الجو الرائع داخل بيت الشيخ عيسى، حيث إن تصميم جُدران الحجرات، والمواد المُستخدمة فيها، جعلها تحافظ على برودة الغُرف في فصل الصيف، لكونها لا تسمح مُطلقـاً بتسرُّب حرارة الشمس داخلها، كما أن تصميم الأفنية الأربعة يُساعد أيضاً في تلطيف الجو، خاصة في وجود بئر للمياه (الجليب)، أضف إلى ذلك وجود الرواشن، والنوافذ ذات التيجان، والتي تأخذ هيئة أقواس (كمر). ومن البيوت التقليدية البحرينية، التي تتسم بالطابع المعماري المُميز أيضاً، بيت الجسرة، المُشيَّد بأسلوب هندسي يتلاءم تماماً مع طبيعة مناخ المنطقة، حيث الجُدران السميكة لعزل الحرارة الخارجية، والملقف الهوائي المركزي، الذي يُحيط بسطح البيت، ليجلب المزيد من نسمات الهواء البارد إلى الداخل، وفتحات التهوية بكُل الغُرف، مع اتساع فِناء البيت، مما يُساهم في احتواء التيارات الهوائية.
وفي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، شُيِّدت “ملاقف الهواء“ المركزية في بعض البيوت التقليدية، إلاَّ أنها لم تكن بمُستوى الانتشار الذي شهدته البيوت التقليدية في كُل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد الأحساء المنطقة الأبرز في المملكة العربية السعودية التي استُخدِمت “ملاقف الهواء“ المركزية في بيوتها التقليدية، وكانت تُسمى “البارجين”. وحول ذلك يُحدِّثنا أ.د. مشاري بن عبدالله النعيم فيقول: “رُبَّما كان تحوُّر الاسم قد نتج عن أن ملقف الهواء المعروف في الأحساء، يختلف كثيراً من حيث الشكل، عن الملاقف الموجودة في المُدن الخليجية الأخرى، ما عدا مدينة الكويت، التي تشترك مع الأحساء في كثير من العناصر المعمارية التقليدية، بما فيها أبراج الهواء”. وجدير بالإشارة فإن المنطقة المعروفة بحي الرفعة الشمالية، في الأحساء، هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر من “ملاقف الهواء“ المركزية، وقد ظهر منها طرازان: ملقف السطح، الذي جاء تصميمه كفتحة موازية في جدار السطح، وظيفتها توجيه الهواء إلى الداخل؛ وملقف الغُرف، وهو عبارة عن قناة بالجدار، ذات فتحة في الأعلى، تُفتَح للخارج، وفتحة بالأسفل، تُفتَح إلى داخل الفراغ الوظيفي المُغلَق (المسقوف)، لتعمل على تهويته.
وفي مدينة الدوحة، يوجد حالياً نموذج واحد فقط لملقف الهواء المركزي، وهو الموجود في بيت محمد سعيد نصر الله، في براحة الجفيري (متحف التقاليد الشعبية).
مآرب أخرى
وإذا كانت الوظيفة الرئيسة لملقف الهواء المركزي التقليدي، هي التبريد والتهوية الطبيعية للغرف والقاعات داخل المبنى، فإن ثمة فوائد أخرى له، من بينها:
أنه يُمثل عُنصراً معمارياً جمالياً، يُضفي على الهيئة العامة للمبنى مزيداً من الجمال البصري، الذي يستشعره الناظر من الخارج. وكان فنتوري، وهو من روَّاد التأريخ المعماري، قد أسهب في الحديث عن ذلك، من خِلال دراسة قيِّمة له بعنوان “التأثيرات الجمالية في العمارة”. وبحسب سكروتن Scruten، فإن الصفات الرمزية للعمارة، أكثر استمرارية من وظيفتها النفعيَّة، التي تمر بحالات التغيُّر والتحوُّل عبر الزمن، ومن ثم فإن ملقف الهواء، تحوَّل من عُنصر يُرضي الوظيفة المناخية، إلى عنصر بصري يُرضي الحاجة الرمزية. وكان رودولف قد أشار إلى أهمية ملقف الهواء من المنظور الجمالي البصري، وقال إنه يُحيل المبنى إلى مَعلَم معماري موحٍ، ويُضفي عليه مزيداً من اللمسات الفنيَّة الجمالية التزيينية، ليس في فترات النهار وكفى، بل وأيضاً في فترات الليل، وخاصة الليالي المُقمِرة، حيث تنعكس عليه الأضواء، وتتكوَّن الظِلال، ولعل هذا ما جعل كثيرًا من أهل الفن التشكيلي، يستلهمونه في أعمالهم، رامزين من خلاله إلى عمارة الزمن الجميل.
وتمتد تأثيرات الملقف الهوائي إلى الناحية الاجتماعية، حيث أفضت نتائج دراسات وأبحاث عِدَّة، إلى أن “ظهور ملقف الهواء، كان نتيجة انفتاح البيئة العمرانية، في المدينة العربية والإسلامية، على الداخل دون الخارج، ولكونه يجلب الهواء بطريقة رأسية، عبر فتحاته العلوية، فإنه يُساهم في حِفظ الخصوصية، وتلبية مُتطلَّبات الراحة المنشودة لقاطني البيت“.
ومن الجانب الصِّحي، ثبت أن هواء الملقف، يأتي نقياً خالياً من الأتربة والعوالق وذرَّات الرمال، التي عادة ما تنتشر بالقُرب من سطح الأرض، في المناطق الحارة، وهو يُجدد الهواء بطريقة مُثلى، حيث يُغيِّر الهواء المُشبَّع بغاز ثاني أكسيد الكربون، بهواء خارجي جديد مُنعش، به كثير من الأكسجين، المُفيد لصِحة الأنفس والأبدان، كما يُساهم في إزالة الدُخَّان، والتخلُّص من الروائح والأبخرة الرطبة، الناتجة عن الطهي، ويمنع ترسُّبها وتكثفها داخل الغُرف، وهو يستحق بجدارة لقب “فِلتر الهواء الطبيعي المِثالي“، في البيئات الجافة والحارة على وجه الخصوص.
ويُعتبر ملقف الهواء صديقًا للبيئة، حيث ينسجم معها، ولا يُعاديها، خاصة وأن جُل الخامات المُستَخدَمة في تشييده هي خامات من البيئة المحليِّة. وهو موفِّر اقتصادياً، حيث لا يُكلِّف أيّ أعباء اقتصادية كبيرة، إلى جانب العديد من المآرب الأُخرى، التي يوفِّرها ملقف الهواء، مِثل توفير الإضاءة الطبيعية، التي لا تُتعِب النظر، حيث لا يوجد سطوع مُباشر لأشعة الشمس، ومُخفِف جيِّد للضوضاء القادمة من الخارج، ويمكن وضع أوعية مياه الشرب الفُخَّارية، على كوَّات صغيرة، داخل الملقف، للحصول على مياه مُبرَّدة بشكل طبيعي، وغير ذلك من المآرب.
كان غير واحد من الباحثين والعُلماء المعنيين بدراسة نُظم التبريد في العمارة التقليدية، قد أشاروا إلى أهمية ملقف الهواء المركزي. يقول وارن جونسون: “إن البادكير، أو برج الهواء، هو نموذج مثالي، يُبيِّن مدى قُدرة المعماري على التكيُّف مع الواقع، وتوظيف عناصر المناخ، في خِدمة العمارة. إنه يعمل كمُستودع للكُتلة الحرارية؛ فالأحجار التي تدخل في بنائه، تبرد ليلاً، وفي نهار اليوم التالي، حينما يبدأ الهواء بالدفء، بفِعل حرارة الشمس، يظل البادكير بارداً، وتكون النتيجة أن الهواء الذي يُلامس البادكير، يتعرّض للتبريد. ولما كان الهواء البارد أثقل من الهواء الدافئ، فإن الأوَّل يهبط عبر قنوات البادكير، ليُنعش سُكّان المبنى حين يصل إليهم”.
وقد خلصت دراسة قام بها فريق بحثي، بمدرسة العمارة التابعة للجمعيَّة المعمارية البريطانية، في أبريل عام 1973م، حول قياس مدى تدفُّق الهواء عبر البراجيل، إلى أن “ملقف الهواء الذي يعلو المبنى بارتفاع مدروس هندسياً بشكل جيِّد، يُعد بمثابة وِحدة تكييف مركزية تقوم بتوزيع الهواء بطريقة عبقرية داخل القاعة الرئيسة، والغُرف المُطلة عليها”.
وكان قد أُجري في العام 1985م، بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة بحث موسّع للوقوف على مدى فائدة ملقف الهواء، وإمكانية الاستفادة منه في توظيف تقنيات التكييف المُتقدّمة. وفي تجربة علميَّة، تمت الاستعانة بهيكل يُشبه ملقف الهواء، أُخِذت أبعاده بصورة هندسية دقيقة، مع إضافة مضخَّة، لترطيب الوسادة الموضوعة أفقياً، على الجهات الأربع، بسُمْك أربع بوصات، والنتيجة أن وجَد الباحثون اختلافاً ملحوظاً في درجات الحرارة، بين الجو الخارجي والداخلي، يصل إلى نحو عشر درجات مئوية، في أشد فصول السنة حرارة. وقد ثبت أن “ملاقف الهواء“، تُعد حلاً مثالياً للتوزيع العادل والاستفادة من مطالع هبوب الرياح، في العمائر المُتقاربة، والتجمّعات السكنية. وكانت عِدة مراكز بحثية معنية بالهندسة المعمارية، قد درست سُبل إيجاد التوزيع الأفضل لمجموعة مبانٍ، بحيث لا تحجب ارتفاعاتها نسائم الرياح عن بعضها البعض، ولم ينجح أي تصميم عصري في حل هذه المُعضلة، لأكثر من ست أو سبع بنايات مُتجاورة، في حين تبيَّن أن الملقف اختراع عبقري يحِل هذه المعضلة.
وعن “ملاقف الهواء“ العربية يقول المِعماري الشهير بول رودولف Pawl Rudolf: “إنها عُنصر رائع من عناصر المبنى المُستدام، الذي يتوافق مع البيئة Bio Climatic Architecture، ودليل على مدى العبقرية التي كان يتمتَّع بها البنّاؤون القُدماء، للبحث عن حلول لتزويد المباني بالهواء العليل، خاصة في المناطق التي يتسم مناخها بالحرارة الشديدة“. قريب من ذلك نتائج أبحاث ودراسات قام بها كُل من كاتنجهام، وسمبسون، وجيفوني وغيرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب وباحث من مصر
المراجع:
1 ــ ابن المجدي، شهاب الدين أحمد بن رجب بن طغيا: تُحفة الأحباب في نصب الباذهنج والمِحراب (مخطوطة بدار الكُتب المصرية).
2 ــ ابن الرامي: الإعلان بأحكام البيان ــ تحقيق عثمان، د. محمد عبد الستار ــ طبعة الإسكندرية 1988م.
3ــ الخفاجي، أحمد بن محمد: شفاء العليل من كلام العرب من الدخيل ــ القاهرة 1382هـ.
4 ــ دراسات ومقالات منشورة لكاتب الدراسة (حسني عبد الحافظ):
ــ نظم التبريد في العمارة الخليجية ــ مجلة التربية ــ فصلية مُحكِّمة ــ العدد 139 ــ سنة النشر 2001م.
ــ “ملاقف الهواء“ في العمارة الإسلامية ــ مجلة التربية ــ العدد 170 ــ سنة النشر 2009م.
ــ الرواشين.. شاهد على عبقرية الفن الإسلامي ــ مجلة الثقافية ــ تصدر في لندن ــ السنة الثانية ــ العدد الخامس عشر ــ جمادى الأولى 1417هـ.
ــ أبراج الهواء ــ مجلة بيئتنا ــ العدد 29 ــ يناير 2001م ــ تصدر في الكويت.
5 ــ مجموعة مؤلفين: الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية ــ الجزء الرابع (العمارة) ــ الناشر دار الدائرة للنشر والتوثيق ــ الطبعة الأولى ــ الرياض 1420هــ، 2000م.
6 ــ عبد الجليل، د. محمد مدحت جابر: العمران التقليدي في الإمارات العربية المتحدة ــ مركز زايد للتراث والتاريخ ــ الطبعة الأولى ــ العين (الإمارات) 2000م.
7 ــ جونسون، وارن: المحافظة على التبريد والتدفئة في العمارة الإسلامية ــ ترجمة الفقي، م.محمد عبدالقادر ــ أرامكو وورلد ــ مايو / يونيو 1995م.
8 ــ البيني، ماركو: العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية ــ ترجمة الجوهري، أسامة محمد ــ الناشر الإدارة العامة للآثار والمتاحف ــ الرياض 1411هــ ، 1991م.
9 ــ إبراهيم، د. محمد عبدالعال: العمارة الخليجية بين الأمس واليوم ــ الناشر دار التراث الجامعية ــ بيروت 1405هـ ، 1985م.
10 ــ النعيم، د. مشاري بن عبدالله: ملقف الهواء (إشكالية الشعبي / الكوني) ــ مجلة المأثورات الشعبية ــ عدد مزدوج 53/54 ــ يناير / إبريل 1999م.
11 ــ فتحي، م. حسن: الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية ــ جامعة الأمم المتحدة ــ الطبعة الأولى ــ طوكيو (اليابان) 1988م.