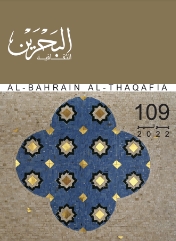السر وراء النهر

نصوص
السر وراء النهر
عبدالحميد القائد*
ذاك الحي القابع في دهاليز الذاكرة، لا يُغادر.. يغفو.. يصحو..
يغتسلُ بأمواج البحر، وفي ضباب الفجر يسترخي.. يحلمُ…
حتى يذوب في انهيارات الرذاذ.
كان حي الفاضل، أو ما يُسمى باللهجة البحرينية الدارجة “فريج الفاضل”، يطلُّ مباشرة على البحر، شهد التاريخ العتيد للميناء البحري القديم الذي كان يعجُّ بحركة البوانيش والسفن والمراكب بـأحجامها المختلفة. هذا الحي، الذي كان يضم مواطنين عرباً من سلالات وأعراق مختلفة، أغلبهم من القادمين في الأصل من بلاد فارس المنحدرين في معظمهم من قبيلة بني تميم، إلى جانب بعض العائلات النجدية التي نزحت إلى البلاد، وفئات أخرى كانوا يعيشون معاً في وئام، وفي مزيج ودّي فريد.
في الربع الأول من القرن العشرين، شهدت البلادُ موجات متفرقة من وباء الطاعون القاتل، كل موجة حصدت أرواحاً كثيرة، واستمرت الموجات حوالي خمس سنوات، إلى درجة أنه كان يصعب على الناس دفن موتاهم من ضخامة عددهم، في زمن كانت الخدمات الطبية فيه شحيحة وغير متطورة.
كانت “أمينة” من حي الفاضل من بين الضحايا، تركت طفليها “علي” و”زليخة” يتيمين، فتعاون الجيران على تربيتهما في ذلك الزمن الحنون. فلم يكن لهما عائل، نظراً لأن والدهما كان بحّاراً يقضي معظم وقته في البحر.. كان صديق الموج، وعاشق الماء الأبدي.
عندما عاد البحّار عبدالله، والد “علي” إلى اليابسة، بعد أشهر عدّة فُوجئ بوفاة زوجته التي كانت عراقية الأصل، فشعر بالصدمة والندم معاً، لأن أطفاله ظلوا بلا عائل طوال تلك الفترة، ولم يكن أمامه سوى أن يتزوج بأخرى لكي ترعى أطفاله، فتزوج ابنة الجيران الحسناء: شمسة، المرأة ذات البياض اللافت، والعيون الحوراء. كانت شمسة حلم شباب الحي، لكنها فضّلت أن تتزوج عبدالله، والد علي، لأسباب عدّة، أولها أنه بحّار معروف، يملك سفينة ويكسب من عمله في البحر وفي تجارة اللؤلؤ التي بدأ قبل فترة قليلة في ممارستها. والسبب الثاني، وربما الأهم، أنه كان يقضي معظم أوقاته في البحر، والطواف بين موانئ الخليج، وصولاً إلى ميناء ممباسا في كينيا، مما يتيح لها أن تظل في كنف عائلتها، وكأنها لم تتزوج، وتتمتع في نفس الوقت بالرفاهية النسبية التي يوفرها لها زوجها عبدالله، لأن عائلتها كانت تعاني من ضنك العيش. كانت شمسة جميلة، لكنها كانت قاسية القلب، وفظة في تعاملها مع علي وزليخة، اللذين واجها معها الكثير من سوء المعاملة، على الرغم من أن أهلها كانوا طيبين، واهتموا بطفليه في غيابه، وهو السبب الرئيسي الذي جعل عبدالله يتزوجها، إضافةً إلى جمالها اللافت.
في صبيحة يومٍ شتائي، يومٍ لا يختلف كثيراً عن باقي الأيام البائسة بالنسبة إليه، كان المطرُ يهطل بغزارة في الخارج. استيقظ “علي” ومياه الأمطار تتسلل من تحته، وهو مستلقٍ على أرضية المطبخ، وتبللهُ، وفرائصه ترتعش من البرد. دخلت عليه زوجة أبيه وهي تصرخ كعادتها، وطلبت منه أن ينظّف الأرضية من المياه. وبينما كان يقوم بالتنظيف، انزلقت رجله وسقط أرضاً، مما أدّى إلى تهشّم بعض الأوعية الزجاجية. استشاطت شمسة غضباً، وتناولت ملعقة الطبخ الكبيرة “ملاس”، وهوت بها على رأسه، وبدأ الدم يتدفق بغزارة، فغادر البيت مذعوراً لا يدري إلى أين يُولِّي الأدبار. شعر في تلك اللحظة أن العالم وحشٌ ضخم، كلاب مسعورة تعدو خلفه.. الأمكنة انطفأت داخله، يبكي بحرقة، ويتمنى أن يرتمي في حضن والده البعيد دائماً في أحضان البحر، والنوارس تحرسه من كل جانب، وهو وحيدٌ وحيد، لا سماء تحميه ولا أرض. دخل إلى منطقة الميناء المواجهة لبيته، فوجد سفينة (بانوش) تتأهب للرحيل، فتسلل خلسةً واختبأ في الأسفل بين البضائع المكدّسة، حتى وجد نفسه والسفينة في عرض البحر، وصوت الريح لا يكف عن الزفيف، وأصوات النوارس تتناغم مع لطمات الموج. كانت تلك السفينة متوجهة إلى البصرة. وفي رواية أخرى، أن أحد النواخذة شاهده في حالته البائسة، ورأف بحاله، وساعده على الهرب للالتحاق بجدته لأمه “فاطمة” في الزبير. كان ذلك –كما يقال- عندما كان “علي” في حوالي سن الثالثة عشرة من عمره، وقال آخرون إنه لم يتجاوز سن السادسة.
حاول عبدالله أن يعثر على ابنه “علي” بعد أن فشلت قوى الأمن في العثور عليه. طاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً. بحث في كل مكان، في القرى والمدن، في الموانئ، في البحار، حتى في البلاد المجاورة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل. كان يدعو الله ليلاً ونهاراً أن يفرج كربته، ويعيد إليه فلذة كبده، حتى أنه لجأ إلى السحرة وكاشفي الغطاء والعرّافين. قالت له إحدى العرافات بأن ابنه ما زال هنا وهناك، طواه الزمن خلف بحارٍ أقل ملحاً، أقل قسوةً، أكثر حباً، نجا من الأفول، وسينجو من الغيابِ دائماً بفضل رحمة الرب. منذ ذلك الوقت، أصبح عبدالله لا يعير شمسة اهتماماً، بل إنه أسقطها من يومياته، لأنه شعر أنها ربما كانت السبب وراء اختفاء ابنه، ولم يكن متأكداً. اختفى ذلك البريق الذي كان يتلألأ في عينيه، ربما إلى الأبد. طلب من أم شمسة أن ترعى ابنته زليخة، لأنه كان يثق في طيبتها، وبأنها امرأة قلبها النقي يشعُّ من عينيها. ومرة أخرى، اضطر عبدالله أن يتزوج، واقترن بفاطمة جعفر التي أنجب منها عائشة ومريم. تقول الرواية بأن عبدالله تزوج أكثر من سبع مرات في العديد من البلدان التي كانت ترسو سفينته في موانئها، وإحدى زوجاته كانت من فيلكا في الكويت، ولم يُعرف إن كان لديه أي أبناء آخرين من زيجاته الكثيرة. لكن حزنه على ابنه “علي” لم ينتهِ، وظل دبّوساً ينخر في روحه، حتى وافته المنيَّة، وعيناه تنظران إلى السماء خشوعاً وتوسلاً!!
بعد سنواتٍ طويلة، رست باخرة في ميناء المنامة، قادمة من البصرة، نزل منها رجل أسمر، طويل القامة، ضخم الجثة يرتدي بدلة ضبّاط البحرية، ويتحدث اللهجة العراقية، جاء يبحث عن أهله. كان ذلك هو “علي”، الذي اصطحبه ابن عمته جاسم إلى بيت أخته “زليخة” في فريق الفاضل، وإلى الحورة ليقابل أختيه “عائشة” و”مريم”. عندما وصل إلى بيت أخته عائشة، تفاجأ زوجها بهذا الرجل الغريب الملامح واللهجة، ولم يصدق أنه شقيق زوجته، ولكنه تقبّل الأمر على مضض، بعدما أكد له جاسم، بل أقسم بأنه شقيقها. دام هذا اللقاء سويعات قليلة، نظراً إلى أن باخرته كانت قد رست في الميناء لساعات قليلة، وانتهز الفرصة ليرى أهله. وأصرَّ على أن يرى زوجة أبيه “شمسة”، فاصطحبوه إليها. شمسة لم يتركها الزمن على حالها، فقد كبرت كثيراً، واختفت كل ملامح جمالها السابق. فالجمال الحقيقي ينمو ويتنامى في القلب النقي، والوجه عادةً مرآة القلب. وعلم في تلك اللحظة أنها أنجبت من أبيه ولداً جميلاً -كما وُصف له- اسمه “سعيد”، ركب البحر مرة ولم يعد، ربما ابتلعه الموج في كبده السري. عاشت شمسة فجيعةً لا يمكن وصفها، ربما فعلت “الكارما” فعلتها، فأعاد لها الزمن رماحها حادةً لتدمي روحها أبد الدهر. نظرت إليه شمسة نظرةً رأى فيها كل ندم العالم.. سقطت من عينيها دمعة.. صمتت وهو يودعها، ربما الوداع الأخير.
اختفى “علي” مرة أخرى، ولم تسمع العائلة عن أخباره شيئاً بعد ذلك، ويُقال إنه توفِّي في مدينة الفاو من قضاء البصرة، غريباً عن بلده الأصلي، ودُفن في مقبرة الدواسر التي اندثرت تماماً في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية. لكنه، وقبل أن يمضي إلى حيث لا يعود الراحلون، جمع أولاده: حسين، ومحمد، وزكية، وعبدالله، حوله وحكى لهم عن السر الكبير، وبأن لديهم عمّات في البحرين، لكن الظروف المعيشية ووسائل اللقاء لم تكن متوافرة في ذلك الوقت، مما حال دون تواصلهم.
مرة قرر مجيد ابن عائشة أن يزور أهله في مدينة الفاو، فاستقل طائرة إلى مطار بغداد، ومن هناك استقل القطار إلى البصرة. عند وصوله إلى البصرة، استعان بسيارة أجرة لتأخذه إلى العنوان الذي معه، وعانى هو وصاحب التاكسي صعوبات جمّة في تلك المنطقة الفقيرة للعثور على البيت المقصود، وطلبا مساعدة شرطي وجداه في المنطقة، حيث أصرَّ ذلك الشرطي على مساعدته، وركب معه السيارة. وكان مجيد طوال الطريق يقصُّ عليهما حكاية خاله بصورة درامية مؤثرة. وأخيراً، وبعد الكثير من المشقة، وصل إلى بيت “حسين”، أحد أبناء علي. طرق الباب، وخرج “حسين”، فقدم له مجيد نفسه بـأنه ابن عمته، تفاجأ حسين وأجهش بالبكاء من هول المفاجأة، وتعانقا طويلاً، عناق الدم الواحد. كانت لقطة درامية مؤثرة، ولم يتمالك صاحب سيارة الأجرة والشرطي نفسيهما، وغرقا أيضاً في بكاء عميق أوقظ النهرين من سباتهما الحزين.
دعته العائلة لتناول العشاء في مطعم بسيط يطلُّ على شط العرب، وهو مكان التقاء نهري دجلة والفرات. كان عدد الحاضرين حوالي عشرة أشخاص، رجالاً ونساءً. كانوا متعطشين لمعرفة أخبار أهلهم في البحرين، فيما كان مجيد أكثر فضولاً لمعرفة تفاصيل حياة خاله. ومن بين الأحاديث، استشف أنّ خاله عندما وصل إلى البصرة، ظل شريداً لفترة ينتقل من منطقة إلى أخرى، عمل عاملاً في المقاهي، وفي التنظيفات، حتى عثر على جدته، والدة أمه، وهناك تغيّرت حياته كلياً، حيث أتيحت له الفرصة لإكمال دراسته، وكان يعمل إماماً في مسجد لفترة من الزمن، حتى التحق بالبحرية وتزوج.
تفاجأ مجيد عندما انضم إلى المجموعة شاب في مقتبل العمر، كان نسخة طبق الأصل من خاله “علي” حسب الصورة التي رآها لخاله، والتي كانت معلقة على جدران بيت ابنه “حسين”. جاء على عجل وكأنّه بالكاد وصل إلى هذا المكان. كان أكثرهم أناقة نسبياً. جلس قبالته، وكانت عيناه لا تفارقانه أبداً، فسأله عن اسمه، وتفاجأ بأن اسمه “علي”، كان ابن إحدى بنات خاله، طويلاً، أسمر اللون، عيناه سوداوان عميقتان، يسكنهما قلق يحاول جاهداً أن يخفيه، ولكن دون جدوى. شعر مجيد بأن تاريخ خاله يسكن في عيني هذا الشاب، وفي دمه، وتلاوينه، وحناياه.
- لا تحسبني مجنوناً. أنا ظاهرة غريبة. أحلمن (أحلمُ) وتتحقق أحلامي، وأرى ما لا يراه الآخرون. حلمتُ بحياة جدي “علي” بكل تفاصيلها، وكأنني كنتُ أنا هو، حتى أنتَ جئت في الحلم، وعلمت أنك ستأتي إلينا. جئتُ ومعي عاد جدي لينتقم من ماضيه.
- ينتقم من ماذا؟
- من زوجة جدي القاسية التي أذاقته الجحيم، من ابنها سعيد. أنا أعلم أين أجد أطفاله.
- سعيد ابن خالي اختفى منذ سنوات بعيدة، ولا أحد يعلم إن كان حيّاً أو ميّتاً.
- سعيد لم يكن ابن خالك؛ كان ابن زنا. وحينما علم بالحقيقة، أصيب بصدمة كادت تفقده عقله، فركب البحر واختار أن يعيش بعيداً عن العالم، ناكراً أصله وفصله، وكان يعيش في دولة أوروبية، وتزوج هناك، ولديه أبناء يعملون في التجارة.
صُعق مجيد مما سمعه من هذا الشاب الطائش “علي”، وقرر أن يغادر في صباح اليوم التالي، تاركاً تلك الأسئلة معلّقة دون جواب. وقبل أن يغادر، أخبره أحد أبناء خاله بأن الشاب علي مصاب بلوثة عقلية، أو أنه يتعاطى، ولا يتوجب عليه تصديق ما قاله.
عاد مجيد إلى وطنه مسكوناً بعلامات استفهام... عاد مغمضاً عينيه كي لا يرى ولا يسمع المزيد. فلا مزيد بعد الذي كان!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاعر وروائي من مملكة البحرين