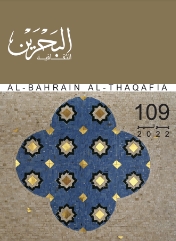الشَّكل في المسرح المعاصر
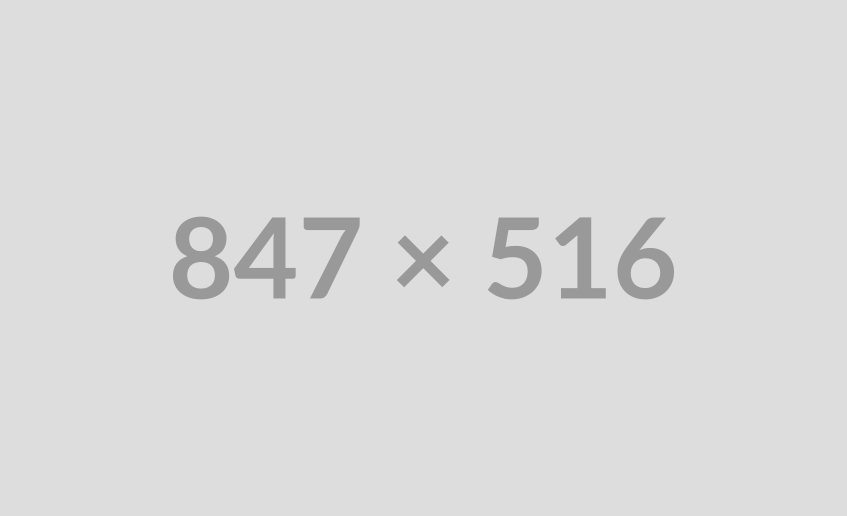
فنون
الشَّكل في المسرح المعاصر
د. محمد زيدان
الشَّكل في المسرح له دلالاته التي تتساوى جماليّاً وبلاغياً مع عناصره الدَّاخلية. فكل ما يمكن أن يكون له شكلٌ في النَّصّ المسرحي –بداية من التَّكوين الدّرامي، ومروراً بمفردات الحكاية، وطريقة عرضها، وانتهاءً بالذَّوات، وكل ما يتَّصل بها، والأشكال النَّصَّية المساعدة، كالفضاءات المسرحية والمفردات المصاحبة لها– يطرح جماليَّات تتفوَّق على جماليَّات الحكاية والفعل المسرحي، والمعنى الذي يطرحه النَّص، سواء جاء هذا الشَّكل ظاهراً، أو جاء متخفّيّاً في ما يمكن تسميته بما وراء الحالة المسرحية “أو خطاب مسرحيٍّ سمعيٍّ وبصريٍّ، لغويٍّ وحركيٍّ، يحيل المتلقّي إلى نسق اللعبة المسرحية”(1).
المسرح –أوَّلاً وأخيراً– يمثّل نوعاً من التَّفكير الجمالي الذي يتحوَّل إلى وجود حيٍّ متحرّك بفعل الشُّخوص والزَّمان والمكان وعناصر أخرى مساعدة، ثم يصبح واقعاً له تصوُّراته، وأفكاره، وأحلامه، وطموحاته. فالمسرح تفكير طموح، سواء بدأ التَّفكير فيه من النَّص، أم من الفكرة الأولى التي تمثَّل نواة النَّص، وحتى تتحقق بوجودها على خشبة المسرح، وهو بذلك يُعد نوعاً من التَّشكيل الفكري الذي يحوّل الحياة العادية إلى صورة جميلة تمثل نمطاً إنسانياً ووجودياً. هذا التَّشكيل لا يلبث أن يقدّم مفرداته عبر الوسائل المختلفة. والبحث هنا يركّز بالدَّرجة الأولى على النَّصّ المسرحي المكتوب، لأنَّ التَّفكير الجمالي المناسب يبدأ من النَّصّ المكتوب للمسرح، وأن تكون الفكرة منذ تأسيسها فكرة مسرحية، وهذا ما يقودنا إلى السُّؤال الجوهري التَّالي:
هل هناك أفكار مسرحية وأخرى غير مسرحية؟
وبتعبير آخر: هل هناك أفكار تصلح للمسرح، وأفكار لا تصلح له؟
الخطاب المسرحي الآن يتمُّ فيه تجاوز الموروث من التراجيديا الإنسانية، “وأصبح البحث عن وسائل جديدة يمكن بمستطاعها عكس واقع الحياة، ووسائل تشجّع الأفكار والعواطف، وتساعد على تحويل التَّركيب الاجتماعي عن طريق الطَّقس الموحّد لكلّ الفنون لخلق احتفال مسرحي”(2)؛ فمن المؤكَّد أنَّ للمسرح غوايته التي يمكن أن تفرّق بين الفكرة المسرحية، والفكرة التي تصلح أن تكون مادَّة لنوع أدبيٍّ آخر. فالمسرح شكلٌ تمثيليٌّ من أشكال التَّعبير الإنساني، يتحوَّل بفعل المفردات المصاحبة إلى نوع من التَّفاعل بين هذا الشَّكل وبين المفردات الأخرى المكوّنة للواقع، وهذا يعني أنَّ هناك وشائج قربى بين المسرح والواقع، والتَّفكير الجمالي يمثّل العناصر المختلفة التي تنتمي إلى كلا الطَّرفين، ومن خلال هذه الوشائج يمكن أن نبحث عن تفكير جديد لشكل المسرح. فمن حقّ المسرح أن تكون له مفرداته البلاغية التي تعين كاتب النَّصّ ومتلقّيه على أن يحقّق نوعاً من البلاغة المسرحية المكوّنة لعناصر التَّفكير الجمالي في المسرح، وبالتَّالي، فإنَّ عناصر المسرح المختلفة والتي يمكن أن نحصيها بين الحكاية المسرحية، والتشكيل المعنوي للحكاية، بالإضافة إلى أشكال الشَّخصيات المسرحية وأنماط التَّفكير في الفعل المسرحي، ثمَّ التَّحوُّلات التي تقدّم العناصر المسرحية، وأخيراً التَّلقّي المتنوّع للفكرة داخل النَّصّ. “ففي المسرحية، تكون العلاقة بين الزَّمان والمكان جزءاً لا يتجزَّأ، ولا يمكن الفصل بينهما. فعلاقة المكان تتوارى، ولا يمكن أن تتكشَّف إلا من خلال الزَّمان، وبهذا الانسجام يوجد النّسق، ويتم تمييز الزَّمان الفنّي باختلاط الزَّمان –بشكل أو بآخر– بالمكان عن طريق الحركة”(3).
هذه العناصر من حقّها أن تقدّم أنساقاً جمالية لبناء نظرية في بلاغة المسرح، وبلاغة المسرح المكتوب على وجه الخصوص، ويمكن بعد ذلك أن تتحوَّل هذه النَّظرية البلاغية للتَّشكيل المسرحي إلى ثوابت من الأفكار الجمالية المكوّنة للنَّصّ حالة تحقُّقه على خشبة المسرح، وهذا لا يعني أنَّ البحث سوف يقدّم نوعاً من البلاغة التي لا تصلح إلا لنوعٍ من المسرح الذّهني، أو الأسطوري، أو غير ذلك من الاتّجاهات المشابهة في الكتابة المسرحية، ولكن الطُّموح يتعدّى ذلك إلى تقديم تأسيس فلسفيّ وبلاغيّ لنظرية في المسرح، ونأخذ في الاعتبار المكوّنات الأساسية للنَّصّ المسرحي، والمفردات المصاحبة، كما نأخذ في الاعتبار كلَّ ما يمكن أن يتَّصل بالتَّفكير الجمالي في النَّصّ، وصولاً إلى ذروة العلاقة بين الفكرة والشَّخصية التي تمثّلها، لأنَّنا في فلسفة النَّظرية المسرحية.
لا بد من الإقرار بأنَّ التَّفكير المسرحي يختلف عن التَّفكير في النَّص القصصي أو النَّصّ الشّعري، لأن أدوات التَّعبير في هذه النُّصوص يمكن أن تتعدَّد أنماطها، وتتفرّع أشكالها حتى تقدّم التَّصوُّرات الخاصّة بكلِّ مفردات العملية الإبداعية. لكن التَّفكير الجمالي في المسرح يبدأ من الفكرة، ثمَّ الشَّخصية التي تحمل هذه الفكرة، ثم طريقة تعبير هذه الشَّخصية عن الفكرة، والمظاهر التي تنتج عن هذه العلاقة، ومن ثمّ تنتج ما يمكن أن نسمّيه ببلاغة التَّفكير الجمالي في النًّصّ المسرحي، وينسحب ذلك على كلّ مفردات التَّعبير في النَّصّ، بداية من الحكاية المسرحية التي تمثّل النّواة الأولى للحالة المسرحية؛ لأنَّ بداية الحالة المسرحية ونشأتها عند الإغريق، أو عند المصريّين القدماء، كانت تحمل إرهاصات لفلسفة الفعل الإنساني داخل النَّصّ، بل كانت تحمل نوعاً من التَّفكير الجمالي لهذا الفعل؛ ألم تكن حالة يتمُّ فيها تقديم صورة تمثيلية، سواء عن طريق المنولوج المسرحي، أو الحوار، لعرض نوع من الأفكار التي تقدّم بدورها صورة من صور الحركة، سواء كانت حركة تمثّل الواقع، أو حركة تمثّل ما وراء هذا الواقع، وبالتالي كان الهدف –منذ البداية– يميل إلى خلق نوع من التَّفكير الذي ينحاز بصورة من الصُّور إلى فعل الحاكي، وكانت التًّحوُّلات التي يقدّمها الفعل المسرحي بمثابة صياغة القانون في حركة الشَّخصيات، وتمثيل الأفكار، وخلق نوع من الحياة المتبادَلة بين التَّفكير وبين حامل هذا التَّفكير، بين صورة الحركة في ذهن الشَّخصية وصورتها بعد أن تصبح واقعاً ماثلاً في النَّصّ المكتوب، ثم بعد تحوُّلها إلى واقع مسرحي، فإنّها تكتسب أبعاداً أخرى.
إنَّ التَّفكير الجمالي المؤسِّس للفعل في النَّصّ المسرحي يقدّم اللبنة الأولى لهذا الفعل في الواقع، مع التَّأويل المناسب، ثم تقديم هذا التَّأويل بما يتلاءم مع تصوُّر الفعل، وتصوُّر الحالة الجمالية التي تصاحبه وتنتج عنه، وهذا ما نحاول تقديمه من خلال التَّصوُّر الذي يميل إلى أن يكون فلسفياً، أي يقدّم الفعل، وأسبابه، وصوره، ونتائجه، والأثر الذي يمكن أن يحدث من وجود هذا الفعل في النَّصّ، والتَّساؤلات التي يطرحها الشَّكل المسرحي. ولذلك لابد من البحث في أسباب وجود شكل مسرحي في زمان ومكان معيَّنين، هذه الأسباب هي اللبنات الأولى للتَّفكير الجمالي المؤسّس للحالة المسرحية، وهي بدورها مؤسِّسة للشّكل المسرحي.

الكاتب الايرلندي صمويل بيكيت
السّياق والشَّكل المسرحي
إذا ذكرنا كلمة السّياق في الحديث عن المسرح، أو الحديث عن الشَّكل المسرحي، فإنّنا نقصد التَّفكير المؤسّس لوجود هذا الشَّكل، ثمَّ أثر هذا التَّفكير في تحقيق نوع من الانسجام بين ثلاث مفردات تتصل بالحالة المسرحية.
الأولى: السّياق المؤسس للحالة المسرحية.
الثانية: التَّفكير الجمالي المصاحب للسّياق.
الثالثة: مناسبة الحالة المسرحية لهذا السّياق.
ففي مسرحية “في انتظار جودو” لصمويل بيكيت، وهي المسرحية التي كتبت في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان السّياق المؤسّس للحالة المسرحية يتمثّل في خروج العالم من الحرب العالمية الثانية مع الدَّمار الهائل الذي أحدث نوعاً من الانحراف في التَّفكير. فجاءت كلُّ عناصر الحالة المسرحية بمثابة البلاغة الحالية لها، بداية من الأفكار، ومروراً بالشَّخصيات، واللغة، وحتى الأثر النَّاتج عن كلّ عنصر من عناصر التَّفكير المسرحي. فكان السّياق هو الفلسفة الخاصَّة للحالة المسرحية، وكانت بلاغة النَّصّ هي الصُّورة غير المنطقية التي جاءت عليها مفردات هذه الحالة.
هنا نتحدَّث عن البلاغة بالمعنى الاصطلاحي المناسب للحالة المسرحية، باعتبارها وسيلة من وسائل توصيل الفعل، ومعبَراً للعلاقة بين الشَّكل وبين العقل الإنساني، وطريقة من طرق تحقُّق الشَّكل والسّياق المكوّن له في النَّصّ. فكان السّياق بمفرداته الواقعية هو الممثّل للحالة البلاغية. فهو المكوّن للشَّكل المسرحي، وهو الذي أوجد الشَّخصيات، وحدَّد اللغة، وأرسى العلاقات المختلفة بين تفكير الشَّخصية وما تقدّمه. فإذا لم تقدّم شيئاً، فقد قدَّمتْ أشياء كثيرة بهذا اللا تقديم.
الحالة ذاتها تتكرَّر، ولكن بتغيير في الشَّكل المسرحي، وربَّما في السّياق المؤسّس للحالة. فاختلفت المنطلقات الفكرية والجمالية، وتشابهت المفردات، ولكن بعد مرور حوالي سبعين سنة؛ فهل يمكن القول إنَّ منطلقات مسرحية بيكيت كانت منطلقات فلسفية خاصَّة بالواقع، والسّياق المكوّن لهذا الواقع؟ وهل يمكن أن تتحوَّل هذه المنطلقات الفلسفية إلى منطلقات جمالية؟ فهي فلسفية للواقع وجمالية للحالة المسرحية، ولأن كلمة “جمالية” يمكن أن تشير إلى نوع من الانسجام بين التَّأسيس والتَّكوين والأثر، فيمكن القول إنها منطلقات جمالية.
المنطلقات ذاتها في النّصف الأوَّل من القرن الحادي والعشرين تبدو غير منسجمة وغير منطقية. ففي نهاية الحرب العالمية الأولى؛ كان السّياق يمثّل نوعاً من انتكاسة كبرى للعالم، تبدَّت في الدَّمار والموت واللامنطق الذي سيطر على العالم كله. أمَّا الآن، فإنَّ المنجزات العلمية تكاد تكون خارج التَّصوُّر العقلي، والرَّفاهية العلمية والتّكنولوجية فاقت كلَّ ما يمكن أن يلفت إلى التَّفكير المنطقي، يعني أنّ لا منطقية الدَّمار والموت يمكن أن تتساوى مع منطقية الإنجاز والرَّفاهية. وبدون حرب عالمية جديدة، نرى التَّراجع الرَّهيب في كلّ ما يتَّصل بالإنسان، والتَّركيز في هذا التَّراجع مثّل مناطق خاصَّة في العالم المعاصر؛ منطقة الشَّرق الأوسط تمثّل النَّموذج لنوع من التَّفكير الجمالي الخاصّ بحالة مسرحية تتشابه في بعض مفرداتها مع حالة لا منطقية الدَّمار والموت عام 1945م. فهل يمكن أن تخرج من هذه المتشابهات مفردات للحالة البلاغية المسرحية؟
فلسفة الحكاية في النَّصّ المسرحي
يقيناً أصبحت الحالة الحاضرة في النَّصّ المسرحي المعاصر حالة فلسفية بالدَّرجة الأولى. وإذا أردنا أن نقفز على التَّعريفات المتنوّعة للفلسفة، نجد أنَّ هناك إجماعاً على أنَّها نوع من المفاهيم المتعدّدة التي تنتج تساؤلات من مكوّنات متنوّعة، وغالباً ما تكون هذه التَّساؤلات وجودية، بمعنى أنَّ طرحها يُعدُّ نوعاً من التَّأمُّل الذي يفضي بدوره إلى تساؤلات أخرى، وفي كلّ مرَّة يمكن أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين شرعية الحالة وشرعية التَّساؤلات التي تطرحها. “إنَّ الجُمل -في أيّ لغة- ليس لها مرجع ذاتي، وإنَّما تتضمَّن مرجعاً خارجياً للعبارة. إنّه الفعل الذي نرتبط به اصطلاحاً، وننجزه عندما نتلفَّظه، وتتضمَّن مرجعاً داخلياً (العنوان)، أو حالة الأشياء التي تسمح لنا بصياغة التَّعبير”(4). وهذا يعني أننا بصدد حالة فكرية متضمَّنة في كلّ أشكال التَّعبير الإنساني. فإذا تحوَّلت هذه الحالة من مجرّد إرهاصات معنوية في عقول الأفراد، إلى أدوات ومفردات نصّية، فإنَّ التَّساؤل الذي يجب أن يكون محطَّ أنظار الجميع: كيف تكوّنت هذه الحالة؟ وكيف تحوَّلت من مجرَّد طروحات نظرية، إلى أدوات وأشكال داخل المجتمع، أيّ مجتمع؟ وهنا يمكن صياغة السؤال كالتَّالي:
- هل يمكن أن يفرز الواقع المعاصر شكلاً فنياً؟
- وهل يتحوَّل هذا الشَّكل من صورته العادية القارَّة في أذهان الأفراد إلى نوع من التَّفكير الجمالي الذي يطرح تصوُّراته من خلال النَّصّ الأدبي بصفة عامَّة، والنَّص المسرحي بصفة خاصَّة؟
ونحن بصدد التَّساؤلات يعني أنَّنا بصدد حالة فلسفية، بين النَّصّ والواقع أو
السّياق المنتج له، والتَّأسيس لهذه الفلسفة الواقعية، تتعدَّى مجرَّد السُّؤال، وتتحوَّل إلى جزء من التَّفكير الجمالي للنَّوع الأدبي، تفكير يحوّل هذه الفلسفة إلى حركة، ويحوّل الحركة إلى شكل، حتى يمكن القول إنَّ فلسفة الحكاية هي نوع من المكوّنات البنائية والبلاغية التي تُعلي الشَّكل، وتحوّله إلى تفكير جمالي، ليس بفعل الاتّساق بين السّياق كمرجع للحالة، ولكن بفعل التَّناص بين السّياق وبين الحالة الفكرية، والتي تتحوَّل بدورها إلى حالة مسرحية. الحكاية إذن في الحالة المسرحية كشفٌ يمكن أن يصبح مكوّناً بلاغياً، وفي الوقت نفسه تمثل صدى للتَّساؤل الذي يطرح السّياق المكوّن لهذه الحكاية. فكلُّ المكوّنات التي تمثل الحالة المسرحية في هذا التَّكوين البلاغي تشير إلى صورتين مؤسَّستين:
الأولى: الواقع بكل مفرداته ومنجزاته.
الثَّانية: الذَّات بكل انكساراتها وأحزانها.
والاتّساق بين السّياق كمرجع وبين مفردات النَّص، هو الذي كوّن مفردات الحالة المسرحية في حكاية “انتظار جودو”. ولنقل إنَّ الفكرة المسرحية ليست موجودة، وإنّما هي أشكال حكائية استثنائية طويلة نسبياً، ظهرت في أحوال الشَّخصيات، وفي هيئاتها، وفي لغتها، وفي كلّ المفردات المسرحية المصاحبة للحالة، كما ظهرت في النُّصوص العربية التي أسَّست لفكرة الاتّساق بين السّياق المنتج للنَّصّ، وبين الحالة المسرحية، ممثلة في سعدالله ونُّوس في “المنمنمات“، وصلاح عبدالصَّبور في “مأساة الحلّاج“، و“مسافر ليل“. ففي “مسافر ليل“، لم تكن حالة حكائية، وإنَّما تحوُّلات حكائية استثنائية، مثل “انتظار جودو“. وفي “مأساة الحلّاج“، كانت الحكاية الواقعية ذات الأثر الغرائبي، والأفعال الغرائبية، كما عند سعدالله ونُّوس، وكلّ مفردات الحالة المسرحية أحدثت الاتّساق بين:
الدَّمار والموت = سياق الحرب العالمية الثَّانية وما بعدها.
أمَّا الآن، فإنّنا بصدد حكايات استثنائية شديدة الغرابة، أنتجت حالة مسرحية وشكلاً حكائياً
يمكن أن نبحث عنه في الحالة السّياقية التي أنتجته:
. العلم ومنجزاته التَّرفيهية الهائلة = سياق القرن الحادي والعشرين.
ربَّما يربط البعض بين سياق الدَّمار والموت في حالة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسياق حالة الدَّمار والموت في منطقة الشَّرق الأوسط (سوريا- فلسطين- العراق- الصّومال- اليمن- ليبيا) مما يعني أنَّنا أمام حيّز مكانيّ وسياق زمانيّ يتشابه –إلى حدٍّ كبير– مع السّياق الذي أنتج مسرح العبث في منتصف القرن العشرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب من مصر
الهوامش
- عوَّاد علي: غواية المتخيَّل المسرحي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1997م، ص42.
- عبد الرحمن بن زيدان: أسئلة المسرح العربي، دار الثقافة للطَّبع والنَّشر بالدَّار البيضاء 1987م، ص71.
- رافد محمود ماشي: بنية الرّواية وتقارباتها في بنية الخطاب المسرحي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، ديسمبر 2018م، ص951.
- جيل دولوز، فليكس غتاري: ما هي الفلسفة، ترجمة: مطاع الصفدي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1997م، ص148