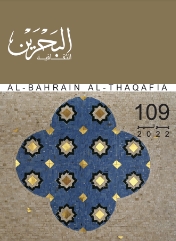تحولات فلسفة الخيال الشعري بين أرسطو وكانط
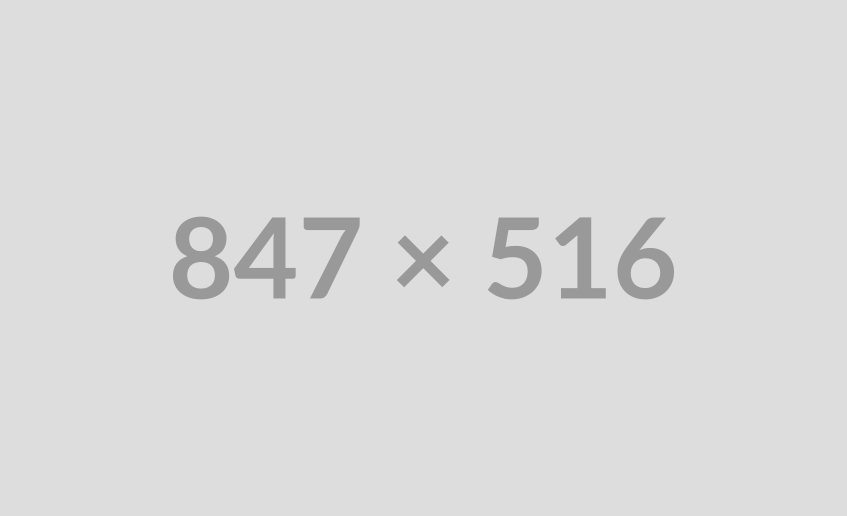
دراسات
تحولات فلسفة الخيال الشعري بين أرسطو وكانط
الدكتور حمد الرَّيّس*
إنَّ النَّظر في مصادر الرُّومنسية في الشّعرية العربية هو تنقيبٌ في مصادر الحداثة الشّعرية العربية الأولى، كما سبق وأن أشار أكثر من دارس1. لكن في حين أنَّ أرشيف الرُّومنسية في ظهورها العربي يتمركز حول الرُّومنسية الإنجليزية والفرنسية وفق ما توصل إليه الدَّارسون، فإنَّ هاتين تُعدَّان انبثاقًا بدورهما للفلسفة الرُّومنسية الألمانية، ولا يمكن – بحال – التَّعرُّف على عمق منجزهما بمعزل عن الأخيرة2. إلا أن الرومنسية الألمانية ذاتها تقف على مفترق طرق بين فلسفة الخيال الشعري القديمة والحديثة، وهو تحول يبدأ بالارتسام مع فلسفة الخيال عند كانط، وقد كان الخيال قد “أصبح عنوان الممارسة الشّعرية الرُّومانسية العربية” بتعبير بنّيس3.
في هذا المقال نبدأ بتوضيح مقومات هذا التحول الفلسفي وطبيعته بقليل من التَّعمُّق، الأمر الذي سبق والتفت إلى أهميته، ومضى في تنفيذه، محمد بنّيس وغيره من الدَّارسين. وسوف نركّز البحث ههنا على مسألة الخيال كقوَّة أو مَلَكة في النَّفس، ونترسّم تحوُّلها في فلسفة الشّعر من الطور الأرسطي (شاملاً الفلسفة الإسلامية الوسيطة) إلى إسهام إيمانويل كانط الفارق، مُشيرين إلى الأفكار الرئيسية التي يتميز بها كل من هذين الطورين في مسلكهما نحو فلسفة الخيال، ولا سيَّما الخيال الشّعري. وقد توخَّينا توجيه البحث نحو هذه المسألة لكون قضية الخيال من كبرى القضايا التي تنتظم حولها فلسفة الشّعر قديمًا وحديثًا، ولكون الجماليَّات الحديثة تمثل تحوُّلاً تاريخياً في التَّوظيف الفلسفي لمَلَكة الخيال، ولكون الموقف من وظيفة الخيال النَّفسية والاجتماعية موقفًا تتميّز به الشّعرية العربية الحديثة الرُّومنسية وما بعد الرُّومنسية، برغم التَّفاوت في عمق التَّصدي والتَّناول بين شاعر وشاعر، أو منظِّر ومنظِّر.
الخيال الشّعري في الفلسفة الإسلامية الوسيطة
بالرُّغم من ضرورة الانتباه (كما سيتَّضح فيما يلي) إلى كون الموقف من ماهيّة الخيال الشّعري يمثل مفترق طرق بين الشّعرية العربية القديمة والحديثة؛ فإنَّ فلسفة الشّعر الحديث لم تقم – بطبيعة الحال – بمعزل عن الممارسة الفلسفية السَّابقة عليها. على أننا – في هذا المستهَلّ – سوف نكتفي بإبراز الفرق بين فلسفة الخيال الشّعري كما نجدها عند فلاسفة الإسلام، وما صار إليه الخيال في فلسفة الشّعر الحديث، خاصة في لحظتها الرُّومنسية، مستغنين بذلك عن تعيين بدايات فلسفة الشّعر مع الإغريق، ولا سيَّما مساهمة أرسطو الرَّائدة، وإن لم نجد بُدَّاً من الاستضاءة بما جاء به أرسطو مِراراً فيما يلي. وبعد، فإنَّ استعراض أفكار طائفة من فلاسفة الإسلام (وإنْ بلمحة خاطفة) يعيننا على تبيئة جذور فلسفة الشّعر عربياً، كما أنَّه عند فلاسفة الإسلام يبلغ التَّنظير الأرسطي إحدى ذُراه العليا، ومسألة فلسفة الشّعر تدور منهجيًّا – شأنها شأن جُلّ مسائل الفلسفة – حول مركز أرسطي.
تمثال الفيلسوف اليوناني ارسطو
استلهم كلٌّ من الفارابي وابن سينا وابن رشد نظرية المحاكاة الأرسطية في مقاربتهم لماهية الشّعر ووظيفة الخيال الشّعري4. ونظرية المحاكاة تقول بأنَّ التَّعبير الشّعري في شكله النَّموذجي لا يعدو تقليدًا أو “محاكاة” (mimesis باليونانية) لما تعاينه النَّفس وتعانيه على أرض الواقع، في سبيل تهذيب النَّفس وحضّها على الفضيلة، بحيث تستقيم خدمة الشّعر لـ”الأغراض المدنية” (بتعبير ابن سينا) عندما تؤدّي هذه المحاكاة وظيفتها في “تطهير” أو “تخليص” النَّفس من العواطف الضَّارة بغايات الاجتماع (وهو ما يُعرف بنظرية “التَّطهير” أو الـcatharsis، والمقصود التَّطهير من الرَّذائل). من هنا ينبري ابن سينا إلى القول بأنَّ الشّعر يوظّف “الكذب” في خدمة الحقيقة. فالمحاكاة – في حدِّ ذاتها – تقوم على ابتكار التخييلات الأكثر موافقة للوقائع (موجوداتٍ وأفعالاً)، تلك التي تمكِّن المتلقّي (مثلاً جمهور المسرح التراجيدي في أثينا، أو متذوّق الشّعر العربي) من التَّحليق على أجنحة الوهم من أجل مواجهة العواطف الضارَّة اجتماعيًّا، والمضطربة في دُخيلاء نفسه ومصارعتها، انتهاءً – في أفضل الأحوال – بتجاوزها، والتَّفوُّق عليها، واستعادة توازنه الأخلاقي.
لذلك يصف كبار فلاسفة الإسلام المخيَّلة – عمومًا – بأنَّها لا تنتج من المقولات إلا “الكذب”، من جهة عدم صدورها عن اعتبار عقلي، إلّا أنَّه كذبٌ قد يخدم الحقيقة الأخلاقية إذا جرى توظيفه بالصُّورة الصَّحيحة في إنتاج العمل الشّعري، من جهة كونه عاملًا مقوّمًا لسلوك الإنسان في هذه الدُّنيا، وربما صبّ في رصيد سعادته الأخروية. “المحاكاة” بهذا المعنى، المحتكم إلى معيار أخلاقي عقلي في المقام الأول، تصبح هي غاية التمثيل الشّعري ومعياره.
يستشفُّ الدَّارس لما كتبه الفارابي وابن سينا وابن رشد في تعليقاتهم على كتاب “فنّ الشّعر“ لأرسطو، أنَّ تناولهم للمخيّلة الشّعرية في مجمله تناولٌ لمُنتَج تلك المخيلة، ولا يكاد يُولي شيئًا من الأهمّية المعرفية أو الأخلاقية لعملية الإنتاج، أو ما يمكن أن نسمّيه بالفعل الإبداعي5. فالنَّماذج التي يتناولها هؤلاء الفلاسفة، والقضايا التي يبحثون فيها، تنصبُّ جميعها على علاقة المتلقّي بُمنتَجٍ شعري ناجز، أمَّا عملية تكوين ذلك المُنتَج فلا تكاد تحظى بأهمّية فلسفية عند تناولهم لماهيّة الشّعر، باستثناء الملاحظات حول “تقنية” أو صنعة الكتابة، من جهة التزامها بقواعد صناعة الشّعر التَّقليدية كما عرفها العرب.
من الأهمية بمكان، إذن، أن نضع نصب أعيننا ملاحظة أُلفت عبدالعزيز حين تقول إنَّ نظرية المحاكاة كما توسَّلها فلاسفة الإسلام لم يكن المراد منها الوقوف على خصائص الفعل الإبداعي للشَّاعر (كما عوَّدتنا مناقشات الحداثة الشّعرية العربية)، بقدر ما كان تقصي تأثير أشكال التَّعبير الشّعري (مثلًا الدّراما التراجيدية والكوميدية والملحمة أو الشّعر الغنائي عند الإغريق، وبالمثل تأثير القصيدة عند العرب)، على نفس المتلقّي6. أي أنَّ التَّناول الفلسفي في العصر الإسلامي الوسيط قد فصل عمليًّا بين التَّخيُّل “الإنساني” و”الشّعري” كما تسمّيه الباحثة، وربما قلنا بين فِعل المخيّلة – بإطلاق العبارة – ومُنتَجها الشّعري، حيث انصبّ تركيز فلاسفتنا في كتاباتهم حول الشّعر، التي نجدها في تعليقاتهم على كتاب الشّعر لأرسطو، على الأخير دون الأول7.
هذه الحيثية تسوقنا إلى أحد المفاتيح الكبرى لتحديد ما يميّز فلسفة الشّعر بمعناها الحديث عن تناول الفلاسفة للشّعر في سالف العصور.
“اكتشاف المخيّلة” بين أرسطو وكانط
إنَّ المطّلع على نظريات الشّعر المؤثّرة في الثَّقافات الأوروبية منذ القرن السَّادس عشر، يقف على نقلة نوعية في مقاربة الموضوع وسبيل التَّناول لا نكاد نلمح لهما مثيلاً في شِعريّات العصور السَّالفة. وإذ لا يختلف المختصُّون على كون الإنجليزي شافتسبيري، والألماني بومغارتن من رُوَّاد هذه النَّقلة، وهي النَّقلة التي تحدّد ولادة علم الجمال كمبحث مستقلٍّ في الفلسفة الحديثة؛ فإنّنا نشهد تأكيدًا مماثلًا من الدَّارسين على كون كانط يصعِّد من تلك النَّبرة المستحدثة، حتى نلفيه واقفًا على أعتاب مفهوم غير معهود للمخيَّلة، وهو ما يدعوه الفيلسوف اليوناني-الفرنسي كورنيليوس كاستورياديس بـ”اكتشاف” كانط للمخيّلة8، وربما كان الأدقُّ أن يوصف ذلك بإعادة اكتشافها، بعد أن قضت دهورًا طيّ النّسيان، مُختَزلةً في وظيفة ذهنية ثانوية لا تتعدَّى إعداد المعطيات الحسّية للفهم.
فبإيجاز شديد، يمكننا القول – رفقة كاستورياديس – إنَّ أرسطو بلغ بنظرية الخيال مداها حين استشفّ في المخيّلة (phantasia باليونانية) قوةً لافتة في جمعها ما بين خصائص عقلية وحسّية رغم استقلالها جوهرياً عن تلك القوَّتين. ولنطّلع على إحدى المواضع التي يشير فيها أرسطو إلى الطَّبيعة التَّناقضية للمخيّلة “لا يستطيع العقل أن يفهم شيئًا أو أن يستفيد علمًا إذا لم يحسّ. فمتى ما تفكّر كان مضطرًّا مع فكرته إلى التَّوهُّم. وذلك أن التَّوهُّم طائفة من المحسوس، إلا أنَّه بغيره أوْلى. والتَّوهُّم غير الإثبات وغير النَّفي، لأنَّ الحقَّ والباطل إنّما يكونان بتركيب المعاني. فأمَّا المعاني الأُوَل فلا فرق في أن تكون ضربًا من التَّوهُّم، أو ما تُخُيِّل عن توهُّم، وإن لم تكن تلك المعاني تخيُّلًا من التَّوهُّم، فإنّها لا تكون بغيره“9.
والحقيقة أنَّ “التَّوهُّم”، وهو التَّرجمة التي اختارها إسحاق بن حنين للفظ phantasia، يضطلع بمهمّة أقوى شأوًا في ترجمة ابن حنين مما نجده في النُّسخة التي يستشهد بها كاستورياديس من نفس النَّصّ الأرسطي في دراسته بالغة الأهمية حول هذا الموضوع والمعنونة “اكتشاف المخيّلة”.10 فالنَّصُّ الذي يثبته كاستورياديس يضع العبارة التَّالية في صيغة سؤال، بينما هي تقريرية عند ابن حنين؛ أعني قوله: “أمَّا المعاني الأُوَل فلا فرق في أن تكون ضرباً من التَّوهُّم”؛ ونفس الأمر مع ما يليها “وإنْ لم تكن تلك المعاني تخيُّلًا من التَّوهُّم فإنّها لا تكون بغيره”. وبغضّ النَّظر عن صيغة العبارة، فإنَّ الفكرة التي تنطوي عليها تُعتبر “راديكالية” في تقدير كاستورياديس، وتستدعي التَّوقُّف عندها طويلًا، ما لن يسعنا فعله ههنا.
قصارى القول في هذا المقام، هو أنَّ المخيّلة (“التَّوهُّم”) في هذا النَّصّ تكتسب دلالة مغايرة لتلك القوَّة التَّابعة للحسّ، دون أن تفقد صلتها به، بل ربما كان من الأفضل القول بأنَّها تراوح ما بين المنزلتين: الحسّ والعقل.
فبعد تقرير أرسطو بأنَّ “التَّوهُّم طائفة من المحسوس”؛ فإنَّ الـ”غير” الذي يشير إليه في العبارة التالية (“إلّا أنَّه بغيره أولى”) إنَّما هو العقل (nous) صاحب “المعاني” (noemata)، بما فيها “المعاني الأُوَل” (و”المعاني” تعادل noemata كما أشرنا، وهي التمثُّلات الواقعة في النَّفس، أو قُل المضامين العقلية، على خلاف “الصُّور”، التي تعادل eide، ومفردها eidos، وهي جواهر الأشياء المعقولة)؛ أي أنَّ المخيّلة “أَوْلى” بما يتمثَّله العقل، بينما هي أيضاً “طائفة من المحسوس”، وبذلك تجتمع فيها خصائص من النَّقيضين: المعقول والمحسوس، أو هكذا يبدو من تأويل النَّصّ.
مهما عنَت تلك العبارة الغامضة “أنَّه [أي التَّوهُّم] بغيره أَوْلى” (والتي لا نجدها في النَّص الذي يعتمده كاستورياديس)، فإنَّ ما لا شك فيه أنَّ النَّصَّ يصرّح بأنَّ “المعاني الأُوَل”، سواء أكانت “تخيُّلًا من التَّوهُّم” لا غير أو مزيجًا بشكل ما بين التَّوهُّم والتَّعقُّل، فإنّها “لا تكون بغير” التَّوهُّم، فالعقل “متى ما تفكّر [theorei] كان مضطرًّا مع فكرته [theorein] إلى التَّوهُّم“.
هذه المخيّلة التي يستدلُ عليها كاستورياديس في النَّصّ المقتطّع أعلاه من الفصل الثَّامن من المقالة الثَّالثة من كتاب النَّفس (ونجد أدلّة مشابهة في الفصلين السَّابع والتَّاسع من نفس المقالة) تكاد تفجّر وهم القسمة الخالصة بين الإدراك العقلي (noesis) والإدراك الحسّي (aisthesis) – “تكاد” فحسب، ذلك أنَّها تجمع بين النَّقائض فيما تستقل عنها وتعلو عليها، لكنَّها لا تمضي إلى أبعد من ذلك. فتعريف المخيّلة – الذي يستمرُّ أرسطو بالاعتماد عليه في بقيّة أنحاء كتاب النَّفس وغيره – ليس من ذلك في شيء، بل هو يعود إلى التَّصوُّر الثَّانوي أو للمخيّلة، الذي يضعها في منزلة التَّابع لأغراض الفهم والعقل، وهو تصوُّرٌ لا يُنكِر بأنَّ “التَّوهُّم حالٌ يتخيَّل لنا فيها شيء ليس بموجود بالحقيقة”11، وأنَّه عامل أساسيٌّ في الإدراك ككل (“يسمّى التَّوهُّم باليونانية باسم [phantasia] وهو مشتقٌّ من الضَّوء [phaos] لأنَّه بغير ضوء لا يمكن أن يرى أحدٌ شيئًا”)12، إلّا أنَّه يُبقي الإشكال معلَّقًا حول ماهية المخيّلة التَّناقضية التي تقترحها النُّصوص متقدّمة الذّكر، ويكتفي – في نهاية المطاف – بتعريفٍ ضامرٍ يعيد المخيَّلة إلى حظيرة الحسّ وينيطها به (“التَّوهُّم حركة من فعل الحسّ“)13، قبل أن يختم الفصل بالعبارة القاطعة التَّالية “وقد قيل عن التَّوهُّم ما هو، ولم كان”14، وكأنَّنا به يضيف “وكفى”15.
مع مجيء كانط، أي بعد أكثر من ألفي عام، نقف على المخيّلة “الرَّاديكالية” – بتعبير كاستورياديس – وهي تحاول الانعتاق مجدَّدًا من ثنائية العقل والحسّ، فإذا بها تتهيَّأ مرَّة أخرى لقفزة غير مسبوقة في تاريخ الفلسفة؛ تتهيَّأ لها فيما تُهَيّئ لها. ففي مكان ما من أعمال كانط، يلوّح للقارئ أنَّ فاعلية المخيّلة لا تنحصر في الوظيفة الاستدعائية، أي القدرة على استحضار المدركات أمام الفهم دون الحاجة إلى حضورها مباشرة في العيان الحسّي، وتتجاوز أيضًا القدرة على توليد الأشكال والأصناف المبتكرَة من تلك المدركات بتجرُّدٍ عن شروط الحساسية. فكل ذلك نجده – بشكلٍ يزيد أو يقلُّ وضوحًا – عند كلٍّ من أرسطو وكانط.
أمَّا في الطَّبعة الأولى (المعروفة بالطبعة A) من نقد العقل المحض، والصَّادرة عام 1781؛ فإنَّنا نقف على شكل غير معهود من أشكال المخيّلة، يدعوه كانط بـ”المخيّلة الترنسندنتالية” (المتعالية). ينيط كانط بهذه المخيّلة المتعالية جملة الحركات الذّهنية الأوَّلية المؤسِّسَة للمعرفة الموضوعية، شاملة معرفة شروط إمكانية المعرفة، وأيضًا مواضيع المعرفة التَّجريبية. هذه الحركات الأوَّلية هي التي تتولّى مهمَّة “التَّأليف القَبْلي” للتَّمثُّلات القائمة أمام الوعي، ويلخّصها كانط في ثلاث حركات، وربَّما كان الأصحُّ وصفها بحركة ثلاثية، تتألَّف من16:
- “تأليف الإدراك في العيان”، الذي يحصِر معطى العيان في “محتوى تمثُّل وحيد” يقع في “لحظة واحدة”؛
- “تأليف إعادة الإنتاج في المخيّلة”، الذي يربط التَّمثلات المفردة النَّاتجة عن تأليف الإدراك في العيان بعضها ببعض، بحيث تكشف معطيات العيان عن “ترافق أو تتالٍ خاضع لقواعد معيَّنة […] تكون الظَّواهر خاضعة لها طوعًا”، وهو ما سبق وأن سمَّتهُ الفلسفة التَّجريبية (الإمبيرية) بقانون تداعي الأفكار (Law of Association)؛
- “تأليف التَّعرُّف في المفهوم”، الذي يَنسِبُ ما ألّفَت بينه المخيّلة في الحركة السَّابقة إلى وعي واحد وموضوع تجربة واحد، محقّقًا شرط إمكان تعقُّل مُختلِف العيان بتوسُّط قواعد موضوعية، أي في مفاهيم.
بإيجاز شديد، فإنَّ هذه الحركات الثَّلاث المترابطة هي المسؤولة – وفق الطبعة A من النَّقد – عن حضور التَّمثُّلات أمام وِحدة الوعي متعيّنةً في زمن واحد، ومنتسبة إلى وحدة وعي واحدة، بدءًا باستيعابها في العيان (أي الحدس المباشر)، ومرورًا بإعادة إنتاجها أو تحضيرها في المخيّلة كتمثُّلات مترافقة ومتتالية، لكي تكون قابلة للتعرُّف مفهوميًّا. أمَّا ما يربط بين هذه الحركات الأوَّلية الثَّلاث المولِّدة لموضوعات المعرفة وما ينظِمها في كلٍّ موحَّدٍ، فهي ملَكة المخيّلة المتعالية لا غير، التي تباين ملَكة الحسّ المتعالية من جهة، وملَكة الفهم المتعالية من جهة أخرى، والتي تَفعَل في الوعي البشري من تلقاء نفسها وباستقلالية نسبية (وذات دلالة) عن شروط إمكانية الفهم.
عن أهمية المخيَّلة المتعالية يقول كانط: “إنَّ المخيَّلة تشكّل مقوّمًا ضروريًّا للإدراك الحسّي نفسه، هذا ما لم يفكّر فيه أيُّ عالم نفسٍ حتَّى الآن كما يجب. وهذا يأتي في جزءٍ منه إمَّا من أنَّهم كانوا يقصرون هذه القدرة على عادات إعادة الإنتاج، وإمَّا أنَّهم كانوا يعتقدون أنَّ الحواسَّ لا تزوّدنا فقط بالانطباعات، بل هي التي تربط فيما بينها أيضًا، وهكذا تشكّل صور الأشياء. ولا شك في أنَّ الأمر يتطلَّب أكثر من قابلية تلقّي الانطباعات، أي يتطلَّب بالضَّبط وظيفة للتَّأليف فيما بينها”17، أي وظيفة للتَّأليف بينها قَبْليًّا، وهي وظيفة المخيّلة المتعالية. وهذا ما يقصده كاستورياديس عندما يقول بأنَّ المخيَّلة المتعالية هي المسؤولة – في الطبعة A من النقد – عن إنتاج “التَّمثُّل الأوَّل”، من حيث هي “مسؤولة عن شكل الانطباعات المعطاة في الحدس وعن اتصالها ببعضها البعض”18.
هكذا تتحوَّل المخيَّلة من ملَكة ثانوية إلى ملَكة تأصيلية، بل وشرطًا للعلاقة المعرفية الجامعة بين الفهم والحساسية، ومن ثَمَّ فهي تصبح شرطًا أصليًّا (لا فرعيًّا، أو تابعًا، أو ثانويًّا) من شروط قيام التَّجربة الإنسانية: “نحن نملك إذًا مخيّلةً محضًا كمَلَكةٍ أساسية للنَّفس البشرية، تقع في أساس كلّ معرفةٍ قبْليًّا؛ وبواسطتها نحن نربط بواسطة مختَلِف العيان من جهة وشرط وحدة الإبصار الضَّرورية [أي ضرورة تحصّل المعرفة في فهم واحد] من جهة أخرى ببعضهما البعض. وعلى هذين الطَّرفين المتباعدين إلى أقصى حد [أي الحساسية والفهم] أن يكونا مرتبطين حتمًا على أساس هذه الوظيفة الترانسندنتالية للمخيّلة، وإلا لما كانت الحساسية لتوفّر فعلًا إلا ظاهراتٍ، ولكن ليس موضوعات معرفةٍ تجريبية، وبالتَّالي تجربة”19.
وإذا اشتبه القارئ المطَّلعِ في نسبة هذا الموقف من المخيلة إلى كانط، فهو مصيب إلى حدٍّ ما، من جهة كون كانط قد قام بمراجعة تلك النَّظرية وحَذْف نَصّها من الطَّبعة المنقَّحة والمزيدة من النَّقد الصَّادرة عام 1787، تلك التي باتت تُعرف بالطَّبعة B، وهي التي أصبحت الطَّبعة المعتمدة، حيث ترتسم معالم الفلسفة الكانطية كما نعرفها اليوم، ولا سيما من تقديم ملَكة الفهم المتعالية على المخيّلة المتعالية من جهة تأصيل مواضيع الوعي. أما أين يحدث ذلك في نصوص كانط على وجه الدّقة وكيف بالضَّبط؛ فقد اختلف المختصُّون. فمنهم من قال بأنّ هذا “الاكتشاف” للمخيّلة المتعالية لا يمكن استخلاصه مما كتبه كانط، لا أوَّلًا ولا تاليًا، بل هو من تداعيات قراءة هيدغر لكانط، التي بدورها تصدر عن قراءة شوبنهاور، ويغلب عليها الإغراق في التَّأويل على حساب الانتباه الدَّقيق للدَّلائل النَّصية المتاحة؛ ومنهم من قال بأنَّ الطَّبعة B لم تعدُ أن انتقلت بالتَّركيز من دور المخيَّلة في تأسيس الوعي إلى دور الفهم، دون أن يعني ذلك إلغاءً لما جاء في الطَّبعة الأولى، وبين هذين الموقفين درجات وأطياف20. وبعد، فكما توضّح جودي لي هيب، فإنَّ المخيَّلة – حتى في الطَّبعة B – تظلُّ مسؤولة عن توليد صورة الموضوع في العيان عن طريق فعلها الذَّاتي، وبالتَّالي تحتفظ بدور أساسيٍّ في إعداد ذات مادّة المعرفة لتَمَثُّل الفهم21.
رغم ما تقدّم من تنبيهات، فثمَّة إجماع بأنَّ هذا “الاكتشاف”، مهما كان مصدره ومدى وضوحه واكتماله في نصوص كانط، لم يكن ليتبلور لولا التَّفاعل الخلَّاق الذي اشتغل به الفلاسفة الألمان ما بعد الكانطيّين – ولا سيَّما فيشته – مع الفلسفة النَّقدية.
ودون الخوض في الجدل الذي لم يخبُ يومًا حول “روح” الفلسفة الكانطية و”نَصّها”، أو “باطنها” و”ظاهرها” – ذلك الجدل الذي اشتعل حال انتباه الحلقات الثَّقافية الألمانية لكتاب كانط المذكور ولم يفتر منذ ذلك الحين – فإنَّه يمكننا القول بأنَّ الصّيغة الأكثر حَدّية للمخيَّلة في شكلها “الرَّاديكالي” توجد في الطَّبعة الأولى من النَّقد. وهذا صحيح، إلَّا أنَّ تلك المخيّلة، في وظيفتها الخلَّاقة، تجد لها أصداء وانعكاسات في غير ذلك مما كتبه كانط ولم يتخلَّ عنه أو يحذفه على مدى حياته، ولا سيَّما في نقد مَلكة الحُكم (وهو الذي استلهمه الرُّومنسيُّون الألمان أيّما استلهام، ولا سيَّما في كلامه حول الغائية الطَّبيعية)، كما في فلسفته الطَّبيعية المتأخّرة (التي باتت تعرف بالـ Opus Postumum) وفلسفته السّياسية22.
خلاصات
لم يسعنا في هذا المقام إلا الإلماح إلى وجه الصّلة بين التَّحوُّل الذي يمثله كانط في فلسفة الخيال ومحورية الخيال في الحداثة الشّعرية العربية، ولا سيما في منطلقها الرُّومنسي، بينما آثرنا الانكباب على استعراض المقوّمات الفلسفية لذلك التَّحوُّل بشيء من التَّفصيل، وتحديدًا فيما يتعلَّق بمخاض فكرة الخيال الخلَّاق، التي سوف تصبح بدورها رايةً عُليا التفَّت حولها شتَّى نزعات الحداثة الشّعرية العربية، بدءًا بالرُّومنسية، كما كانت قبل ذلك الفكرة النَّاظمة للرُّومنسية العالمية أيضًا، بدءًا بالرُّومنسية الألمانية المبكّرة كما طوّرها الفيلسوف شيلينغ ورفاقه ، ووصولًا إلى انتشارها العالمي على يد المدرسة الرُّومنسية الإنجليزية، وعلى رأسها الشاعرين وردزورث وكولردج.
إذن، فـ”اكتشاف” كانط للمخيّلة الخلّاقة – برغم ما يعتريه من التباس، وبرغم المحدودية التي تفرضها عليه صرامة المنهج الترنسندنتالي – يمثِّل – في صميمه – نقطة انطلاق لشعرية جديدة وغير معهودة تاريخيًا في الثقافتين الأوروبية والعربية وغيرهما، وإن كان هذا الاكتشاف بمثابة التَّمهيد لما سيأتي من تبلور على يد ما بعد الكانطيين من مبدعي الرُّومنسية الألمانية المبكّرة، وهو ما يجب تأجيله إلى بحوث تالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أكاديمي من البحرين
المراجع
العربية:
- علاء حسين البدراني، فاعلية الإيقاع في التَّصوير الشّعري (عمّان: المنهل للنشر الإلكتروني، 2017).
- عبدالرحمن بدوي، أرسطوطاليس: فنُّ الشّعر – مع التَّرجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1953).
- عبدالرحمن بدوي، أرسطوطاليس: في النَّفس (القاهرة: مكتبة النَّهضة المصرية، 1954).
- محمد بنّيس، الشّعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها – 2. الرُّومانسية العربية، ط 2 (الدار البيضاء: دار توبقال، 2001).
- كمال خير بك، حركة الحداثة في الشّعر العربي المعاصر، ط 2 (بيروت: دار الفكر، 1986).
- جيهان السَّادات، أثر النَّقد الإنجليزي في النُّقاد الرُّومانسيين في مصر بين الحربين (في الشّعر) (القاهرة: دار المعارف، 1986).
- خالدة سعيد، أفق المعنى (بيروت: دار الساقي، 2018).
- ألفت عبدالعزيز، نظرية الشّعر عند الفلاسفة المسلمين: من الكندي حتى ابن رشد (القاهرة: الهيئة المصرية العامَّة للكتاب، 1984).
- لويس عوض، دراسات في النَّقد والأدب (بيروت: المكتب التّجاري للطباعة والتَّوزيع والنشر، 1963).
- إمانويل كَنْت [= كانط]، نقد العقل المحض، ترجمة: غانم هنا (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013).
- صامويل تيلور كولردج، النَّظرية الرُّومانتيكية في الشّعر: سيرة أدبية لكولردج، ترجمة: عبدالحكيم حسَّان (القاهرة، دار المعارف: 1971).
- محمد مندور، النَّقد والنُّقاد المعاصرون (القاهرة: نهضة مصر، 1997).
- عبدالرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فنّ الشّعر لأرسطوطاليس (إربد: عالم الكتب الحديث، 2011).
الأجنبية:
- Cornelius Castoriadis, World in Fragments: Writings on Politics, Society, Psychoanalysis, and the Imagination, ed. & trans. David Ames Curtis (Standford: Stanford University Press, 1997).
- Jodie Lee Heap, The Creative Imagination: Indeterminacy and Embodiment in the Writings of Kant, Fichte, and Castoriadis (New York: Roman & Littlefield, 2021).
- Günter Zöller, “The Productive Power of Imagination: Kant on the Schematism of the Understanding and the Symbolism of Reason,” in Saulius Geniusas (ed.), Stretching the Limits of Productive Imagination: Studies in Kantianism, Phenomenology, and Hermeneutics (New York: Roman & Littlefield, 2018), 1-22.