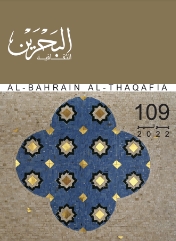سؤال تمثيل المادّة التّاريخيّة بالتّخييل
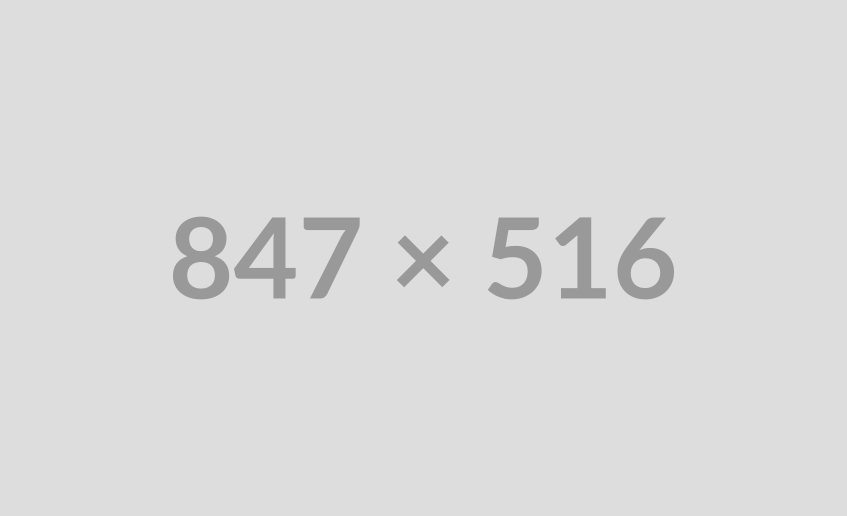
دراسات
سؤال تمثيل المادّة التّاريخيّة بالتّخييل
د. سعيد أوعبو
يعتبر هايدن وايت، من أهمّ منظّري التّاريخ على مدى النّصفِ الأخير من القرنِ الماضي، وهو ينجز كتابه المعنون بـــ“الميطاتاريخ: التّخييل التّاريخي في أوروبا في القرن التَّاسع عشر“i، الكتاب الذي حفَّز أبرز علماء الإنسانية الأمريكيّين على ربط القضايا التّاريخيّة والنّظريّة، ممّا أسهم –بجلاء– في توليد هذا القلق المعرفي الذي يحتاج إلى تعميق أسئلة البحث فيه، بغية معرفة صلة التّاريخ بالإبداع السّردي كتجسيد مباشر –في إطار التّكامل– لمكوّن التَّمثيل الذي يحضر في الغالب باعتباره موجّهاً أساسياً لدرجات انزياح اللّغة في الكتابة، التي تتراوح بين الخيال والتّخييل والتّخيُّل. لكن الشيء الذي نهتمُّ به أكثر هنا، هو محاولة تقريب الرُّؤى خصوصاً في علاقة التّاريخ بالسّرد، وحضوره داخل الكتابة الإبداعيّة بصبغة جديدة، ناهيك عن تقريب حدود التّمثيل السّردي في كتابة التّخييل التّاريخي، علاوة على الكشف عن جملة من النّظريات التي تتيح لنا استقراء النُّصوص السّردية وتفكيكها. ومن هذا المنطلق، نطرح الإشكال الآتي: كيف يمكن التّعليق على وجود التّاريخ في السّرد في ظلّ تمثيله لمرجعيّات تُعنى بنقل المواد التّاريخيّة كأمثولة؟

المؤرخ الأمريكي هايدن وايت
أولاً: موقعة التّخييل التّاريخي
إنّنا ننظر إلى مفهوم التّخييل من جهة السّرد كقرينٍ للثقافة والإنسانية، ويذكّرنا بما يطرحه رولان بارت، كونه موجوداً في كلّ مكان بشكل أوسع. بيد أنّ إحدى تمفصلاته تهتمُّ بفعل التّسريد، ولعلّ هذا الفصل يُستبان حينما نتحدَّث عن السّرد في التّاريخ كخطاب يُسرد، حيث يستحيل أن نقدّم التّاريخ –على سبيل الذّكر لا الحصر– دون سردٍ. أمَّا من جهة التّخصيص، فنستعير عادة حبكة سرديّة تسرد تاريخاً متخيَّلاً، في شكل يتألّف فيه التّخييل التّاريخي.
يرى هايدن وايت، في ما سبقت الإشارة إليه، أنّ السَّرد يغدو “بعيداً عن كونه سنَّة واحدة بين سُنن كثيرة قد تستخدمها ثقافة من الثَّقافات لإضفاء معنى على التَّجربة، هو سُنّة كبرى Metacode، كلّية إنسانيّة، يمكن على أساسها نقل رسائل عابرة للثقافات عن طبيعةِ واقعٍ مشترك”ii. ويستطرد في قطع الشّك باليقين بأنّ السّرد “طريقة للكلام على الحوادث، سواء كانت واقعية أو متخيّلة”iii. ولعلّ هذا الامتداد، الذي عرفه السّرد، انطوى على التّخييل الذي يشكّل معبراً لإعادة تقديم المتخيّل. وفي اطّلاعنا على دلالات المتخيّل، وجدناه -بالشَّكل الأقرب الذي يتمثّل في ذهننا- أنّه “موضوع التّخييل والتّخيل والخيال”iv، وهذا الثلاثي لا يشكّل في إطار الوشائج سوى “متابعة على هيئة مراحل متتابعة متسلسلة… بل هي أقرب إلى العلاقات التّفاعلية الدَّائرية”v، ممّا يجعلنا نُموقع التّخييل بشكل أكبر في علاقته بهذا الثلاثي.
إنّ هذا المسار يجعلنا نقرّ أنّ درجة الاشتغال بالمتخيَّل، بين التّقييد والتّحرّر من الواقعية، هي التي تتيح تعيين طبيعة الموضوع المتخيَّل، ودرجة تمثيله، باعتبار أنّ “العملية التي يتشكّل بها المتخيّل بواسطتها، هي عملية تسمَّى التَّمثيل Representation”vi، ويطرأ في البداية والنّهاية اعتبار الإنتاج الإبداعي غير خارجٍ عن الذّات التي ألّفته وعَمِلتْ على خلقه، وأنّ زاوية طبيعة الإنتاج تُتيح لنا تصنيف العمل انطلاقاً من تقسيمات المتخيَّل ومواضيعِه الثّلاثة، خصوصاً في إطار التَّمثيل. ولقد قال إيجلتون في ظلّ هاته المقاربة، متكلّماً عن الأدب ذي الصّلة بتجلّيات المتخيَّل: “الأدب ليس تبعاً لما إذا كان تخييليّاً أو تخيُّليّاً، وإنّما لأنه يستخدم اللغة بطرائق غير مألوفة. فالأدب في هذه النّظرية، هو نوع من الكتابة التي تمثّل عنفاً منظَّماً يُرتكب بحقّ الكلام الاعتيادي”vii. وهنا تحديداً يُعزى الفعل إلى درجات الانزياح وصيغ التَّمثيل، لأنّهما الفيصل في ترسيخ طبيعة المتخيّل والحكم على نمط تجسيده، فإمّا أن يكون خيالاً، أو تخييلاً، أو تخيُّلاً.
أمّا من جهة التّاريخ، فلا شكَّ أنّه “خطاب حول ما وقع في الماضي”viii، وظهور التّمثيل في التَّاريخ جاء بعد تأخُّر ابتداع الخطاب التّاريخي في التّاريخ البشري، وصعوبة الحفاظ عليه في أزمنة الانهيار الثّقافي (كما هو الحال في أوائل العصور الوسطى) إلى اصطناعيّة الفكرة التي مفادها أنّ الحوادث الواقعية يمكن أن تحكي ذاتها، أو أن تُمَثَّل على أنّها تحكي قصَّتها”ix، الأمر الذي أتاح تسريد التّاريخ وتمثيله في ضوء ما يُصطلح عليه بالتّخييل التّاريخي.
إنّ استعادة التاريخ الجماعي أو الفردي بآلية التّصوير التّاريخي للسّارد، والقائم على التّخييل السّردي كجامع بين التاريخ والسرد والقاطع بينهما في الآن ذاته -بحيث يطفو فعل الهدم ويتنازع التَّخيُّلي بالمرجعي، والإيهام بالتَّوثيق والحقيقة- يقدّم الحبكة كبؤرة أساسية قائمة على مبدأ التّجسير بين موازِيَين هما: التّخييل والتّاريخ المؤدّي إلى تبلُّج هُوية سرديةx. وفي هذا الرّدم، تفطَّن وايت لوجود ما يُصطلح عليه بالتّخييل التّاريخي، الذي يؤلَّف فيه السّرد بحسّ تاريخي. وكما أجادت الذّاكرة الجماعيّة في الاهتمام بأحداث التّاريخ، واستفاضت في تقديمها كخطاب يُسرد؛ فإنّ السُّرود العربية الحديثة لجأت إلى تمثيل الأحداث عن طريق التّخييل التّاريخي في الرّواية العربيّة المعاصرة.
ثانياً: التّمثيل كشرط أساسيّ في التّخييل التّاريخي
ظلّ التّمثيل مقابلاً لفعل التّعويض وتقمّص الأدوار، بعدما كان مرهوناً بالإشارة والحركة التي تحرّرت قليلاً من مطابقة العالم، خصوصاً العالم المتوسّط، لكون العالم اليوم بات مُثقلاً بالمواقف، وغدت الفكرة أكبر من الإشارة نفسها. ويقول فوكو متحدثاً عن هذا التَّغيُّر الذي لحق الإشارة التي تحيّنت: “إنّها تسكن اليوم داخل التّمثيل، في ثنايا الفكرة، في هذا الحيّز الضَّيّق الذي تلعب فيه الفكرة مع نفسها”xi، ممّا يعطي للفكرة القدرة على انتداب مواقف الآخر، بل وأنْ “تتحمّل مسؤولية النّطق بالنّيابة عن الآخرين الممثّلين”xii. ولعلّ هذا التّجلّي قادرٌ على توفير إمكانات رحيبة في احتضان الآخر، واستيعابه وتجسيد توجّهاته الهُويَّاتية.
يدفعنا مفهوم التّمثيل للبحث عن أرضيّة خصبة للتّجسيد، وهي تتحقّق في السّرد خصوصاً في ظلّ تجاوز إشكاليّة المحاكاة عبر مساراتها المختلفة، صوب إمكانية تمثيل المرجعيّات الثّقافيّة والاجتماعيّة والسّياسية، بحيث “لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثيلٍ للذّات وللآخر. فالتّمثيل هو الذي يعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن الآخر”xiii. إنّ مفهوم التّمثيل يقدّم مرتعاً لإضفاء قيمة على المتخيَّل السَّردي الرَّمزي الذي يُعدّ نموذجاً تخييلياً يتيح للمبدع إبداء تطلُّعات المجتمعات، من خلال قضاياه الكبرى كتخييل التاريخ، لِما تتيحه الرّواية من قدرة تمثيلية هائلة في سبر أغوار المكنونات والتَّصوُّرات عن ذواتنا. ويرى عبدالله إبراهيم أنّ قدرة الرّواية التمثيلية “تخوّلها القيام برسم صور مجازيّة عن السّياق الثّقافي الذي تظهر فيه، ولها إمكانية في إعادة تركيب الأرصدة الثّقافية، والمؤثّرات المعاصرة، بما يجعلها تنخرط في إثراء العالم الذي نعيش فيه”xiv، وتجيز لها نقل العوالم المرجعية إلى أخرى افتراضية، بصبغة قادرة على عدم الاكتفاء والتّوقف عند حدود النَّقل، بل تمثيل العواطف والأحاسيس والرُّؤى، وما شاكل ذلك.
ولعلّ الرّواية لها مقدرة عظيمة تتيح لها الفرادة والتّميّز التّعبيري. لكن موازاة لذلك، تبقى مسألة التّمثيل فعلاً معقّداً لما يتغلّفه من صعوبةٍ على صعيد تصوير المواقف ونقل العالم، وقد يحتاج إلى كثير من المهارة والإجادة في تحبيكه سرديّاً، وهو الأمر الذّي يؤكده إدوارد سعيد حينما يقول: “إنّ المقدرة على التّمثيل representation والتّصوير، والتّحديد، والوصف ليست متاحة بسهولة لأيّ كائنٍ كان في أيّ مجتمع كان”xv. ولا شكّ أن تحقّقه بالأحرى، يدفع بنا إلى البحث عن مسوّغات لإعادة تفكيكه، بما يلائم الأبعاد النّظرية التي تتيح العدّة للتَّشريح والنَّقد، والبحث عن المكنونات والمضمرات والقضايا الصّغرى التي يتضمّنها الإنتاج من قبيل: الانشطار، والتَّهجين، والآخريّة، والاختلاف، وما شاكل ذلك من قضايا مطمرة في التاريخ، خصوصاً التاريخ الاستعماري الذي يمثّل فيصلاً أساسياً في التّفاعلات بين الشَّرق والغرب على سبيل التَّمثيل لا الحصر، واكتشاف الذَّات، لذلك ظلّ مرتعاً أساسياً، ومحوريّاً في القضايا التّاريخية التي ترنو الرّواية لتمثيلها.
ثالثاً: نُظمٌ نظريّةٌ لقراءة التّخييل التّاريخي
من بين التّوجهات المرهونة بقراءة التّخييل التّاريخي باعتباره إبداعاً، ما يتّصل أساساً بالخطاب الاستعماري، وبنظريّة ما بعد الاستعمار؛ بغية تحليل وبلورة الحضور الغربي في البلدان المستعمَرة إثر الإنتاج الخطابي من جهة، ومن جهة أخرى صرف النّظر إلى الاستعمار التّقليدي وفعل الهيمنة الإمبريالية التي انتهت وصارت ممّا بعد. ورغم دراسة التّاريخ من خلال هاته النّظريات فإنّ الإشكال ليس متصلاً بالآليات عينها، أكثر من المعارضة القائمة في تباين الآراء بين من يدّعي استمرار الاستعمار وخطاباته التّعسفية، وبين من يراها شيئاً متجاوزاً. ولكي نقيم بعض الحدود بينهما، نوضّح الأطر النّظرية وفق الآتي:
1. الخطاب الاستعماري
يتقدَّم طليعة الخطاب الاستعماريxvi المفكّر إدوارد سعيد، في مؤلّفه “الاستشراق“، بحيث يجعل الاستشراق “أسلوباً للخطاب، أي للتّفكير والكلام، تدعمه مؤسسات ومفردات وبحوث علميّة، وصور ومذاهب فكريّة، بل بيروقراطيَّات استعمارية وأساليب استعمارية”xvii. ولا شك أنّ بروز هذا الخطاب متعلّق –بالدَّرجة الأولى– بالنّظم الكلاميّة والفكريّة، ولعلّ “الأعمال التي قدّمها ممثلو مدرسة فرانكفورت تطرح اهتماماً مشتركاً، تجسَّدت في محاولة صوغ فلسفة نقديّة بديلة، تقف بإزاء التّيارات النّظرية البرجوزايّة التي مارست –ولم تزل– صنوفاً من السّلطة الفكرية، وهدفت إلى تقويض الفصل بين النّظرية والممارسة”xviii. هاته الفلسفة دفعت إلى تحرير المشروع النّقدي الذي استفاد منه المفكر إدوارد سعيد، في مؤلّفه “الاستشراق“، لأنّ المنطلقات الفكريّة للمدرسة تأسّست وفق منظور علميّ، جاء وفق مراحل متتالية، آخر محطّاته جاءت بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، “حيث بدأت المدرسة تمارس تأثيراً مهمَّاً على الفكر في أوروبّا والولايات المتحدة، وتثير حماساً في حركات الشّباب التي تفجّرت نهاية السّتينات مع زيادة اهتمامها بقضايا التّسلط والهيمنة، ونقد النّظم السّياسية والثّقافية، خاصة في المجتمعات الرَّأسماليّة…”xix.
لقد أخذ هذا الخطاب الاستعماري جملة من المفاهيم التي تضمن كينونته من قبيل السّيطرة، لذلك يجعل المفكر إدوارد سعيد، الاستشراق “أسلوباً غربيّاً للهيمنة على الشّرق، وإعادة بنائه، والتّسلُّط عليه”xx. ولا شكّ أنّ الاهتمامات الكبرى بالهيمنة كانت نتاج الاستفادة الكلّية من أعمال أنطونيو غرامشي، الرّجل الذي جعل من المفهوم خيطاً ناظماً يؤطّر أعماله. وقد نظر غروبي لوسيانو إلى الهيمنة عند غرامشي باعتبارها “اللّحظة التي تتحقَّق فيها التَّحالفات أساساً، أي القاعدة الاجتماعية الضَّرورية لديكتاتورية البروليتاريا، باعتبارها الشّكل السّياسي والدَّولتي Etatique الذي تتحقَّق الهيمنة في إطاره. وفي هذا السّياق، تتحدّد الهيمنة بوصفها القدرة على القيادة والسّيطرة”xxi، ممّا يجعل خطاب الاستعمار معادلاً للاستشراق، والمرادف لأساليب الهمينة والقيادة والسّيطرة، بشكل تخلقه المؤسّسات للقيادة الفكريّة والميل للإخضاع، خصوصاً في ظلّ طفو بعض الجماعات المعارضة –عادة– في البلدان المضطهَدة. إنّه بالأحرى خطاب إقصائي يعيد تمثيل الشّرق وفق المصالح والأهداف الاستعماريّة التي يذهب التّخييل التّاريخي إلى إنتاجها، وإعادة تقديمها كأمثولة.
لقد شكّل الاستشراق عند إدوارد سعيد أُفقاً يضمن للباحث مرتكزات نظريّة لإغناء نقاشاته، وتعبئة فراغاته، وهو يتلقّف الخطابات الثقافيّة من قبيل التّخييل التّاريخي، والهُويّة، وسؤال الذَّاكرة، ومختلف القضايا السّياسية والتّاريخية والعرقيّة وغيرها، وإعادة تحليلها وفق المفاهيم الاستشراقيّة المنضوية تحت لواء النّقد الثّقافي الذي أرسى دعائمه، لكون الاستعمار قد ولّد آثاره في كلّ شيءٍ، لذلك تبطّنت في الاستشراق سبل التّحليل، “حيث نبعت تحليلاته من معطيات مثل القوُّة، والسّلطة، وسلطة الإنشاء، والنّصوص المولّدة لذاتها، وترابط المعرفة بالقوّة، والاستعراض، والعجمة…”xxii، وغيرها من المفاهيم التي تيّسر للباحث تفكيك الخطابات بنظريّة قائمة بذاتها.
2. دراسات ونظرّيات ما بعد الاستعمار
جاء ميلاد دراسات ما بعد الاستعمار في (الفنون، وآداب كتابة التّاريخ)، بعد تجاوز الهوس بالمنجز الغربي فكراً ونقداً، كردّ قومي من طرف حركات التَّحرير والحراك الثّقافي، وتفكيك المرتكزات البادية في الخطاب الاستعماري، وشكّلت ردّ فعل مباشر للتّحيز الاستعماري، ومنبعاً لتفرّع دراسات من قبيل: المقاومة والأقلّيات، وأساليب الهيمنة الثّقافية.
إنّ دراسات ما بعد الاستعمار صُمّمت على مقاس ما بعد الحداثة، وقد جاءت كردِّ فعلٍ على التّراث الثّقافي الذي خلَّفته الإمبريالية، وفحْصِ علاقات القوُّة الاجتماعيّة والسّياسية التي تدعم الاستعمار المسلّح والاستعمار الفكري الجديد، وكاستجابة آيديولوجيّة للفكر الاستعماري بكونه إبدالاً لوصف أحداث تأتي بعد الاستعمار، من خلال التّركيز على العواقب الإنسانيّة للسّيطرة على المضطهدين، وعلى استغلال الأشخاص المستعمَرين وأراضيهم. إنّ ما بعد الاستعمار هو تحليل نظريٌّ نقديٌّ لتاريخ وثقافة وأدب وخطاب القوُّة الإمبريالية -الأوروبّية على سبيل المثال في أفريقيا- وقد ظهرت في الثُّلث الأخير من القرن العشرين، في موضعين متباينين:
الأوّل: في الولايات المتَّحدة مع إدوارد سعيد، كمُمهّدٍ ومؤسّسٍ لنظريّة من نظريّات ما بعد الاستعمار، باعتبارها تيَّاراً فكريّاً يهتم بالثّنائيّات بين الشّرق والغرب، وقد استفاد من أعمال سابقة لألبير ميميxxiii، علاوة على اجتهادات فرانز فانونxxiv خصوصاً بعد عثوره على الأسس النّظرية الرّئيسية في ما يتعلّق “بمعارضة المستعمَر للمستعمِر“، لتستمر عمليّات التَّأثر بشكلٍ متواتر مع الذين جاؤوا بعد إدوارد سعيد، سواء معه (مطابقة أو اختلافاً)، أو تأثّراً مباشراً للذين قعّدوا للخطابين الاستعماري وما بعد الاستعماري، ونقصدُ ألبير ممّي وفرانز فانون.
الثاني: في الهند كمهدٍ فعليّ للنّظريات التي تهتم بالحقبة المابعديّة، بحيث عَرفت حقبة ما بعد الاستعمار مجموعة من التّحوّلات، ابتدع من خلالها هومي بابا نظريّة الهُجنة، إثر إعادة التّفكير في مسائل تتعلّق بالهُوية وسؤال الانتماء، لكون الهُجنة أساس الثقافة، بحيث إنّ “الثّقافة المعاصرة مختلطة تماماً مثل الثّقافة الاستعمارية”xxv رغم تباين المواقع، سواء في فضاء المستعمَر أو فضاء المستعمِر. ويقدم بابا نظريّةً فاعلة عن التّهجين الثّقافي، نظرية رائدة بُثت في عمله “موقع الثقافة”xxvi والمهتمَّة بالخطاب التَّواصلي المهمَل وإعادة كتابته بمفاهيم جديدة. ولا شكّ أنَّ عمل بابا يطوّر “مجموعة من المفاهيم المهمّة التي تعتبر أساسية لنظرية ما بعد الاستعمار: الهجينة –الهجنة-، التَّقليد، الاختلاف، والانشطار”xxvii كمفاهيم للمقاومة، ويوفرها أيضاً لدراسة نصوص التّخييل التّاريخي التي تهتمّ بالاستعمار وما بعده. فالأدب بالنّسبة إلى بابا “مركزيّ لعمليّات منظور ما بعد الاستعمار”xxviii. ويجادل بابا بأنّ الإنتاج الثّقافي دائماً ما يكون أكثر إنتاجيّة حيث يكون أكثر تناقضاً. ويستفاد من عمله أنّهُ إلى جانب الهيمنة والسّيطرة المشاعة، هناك جانب من التّواصل والتّفاعل الثّقافي المعقّد والمتنوّع (الممتدّ إلى اليوم) بين المستعمِر والمستعمَر، وتساهم وجهات النّظر ما بعد الاستعماريّة لفهم أصليّ لحاضرنا الاستعماري، كما يقدّمها بابا دائماً. وقد جاء في الموضع ذاته تيار سمّي بــ”دراسات التّابع”xxix، يتضمَّن صفوة من المنظّرين والنّقاد، من قبيل: رانجيت غاها، بارتا شتارجي، شهيد أمين، دفيد أرلوند، مع إسهام جلي من طرف غيتاري سبيفاك، وديبيش شكربارتي.
تذييل لا بد منه
لقد جاء التّمثيل السّردي للاستعمار داخل التّخييل التّاريخي، لتعرية الهدم الثّقافي الذي لحق المستعمرات بأفكار “إمبريالية“ تسعى إلى السّيطرة على الإنسان عن طريق الكتابة الإبداعيّة، وإبانة قاعدة تبعيّة الملوّن للأبيض، وثنائية المُدان والمَدين، مع إعادة عرض المادّة التّاريخيّة عن طريق التّسريد، وإظهار الحقائق التي جرى قلبها وتزييفها، والتي تنظر للكذبة الكبرى باعتبارِ عالم الأبيض –مثلاً– عالماً للقيم والفضيلة، وبأنّ عالم الملوّن عالم لآكلي اللّحوم والغارقين في التّوحُّش والبدائيّة، والبعيدين عن حيازة الصّفات البشرية، والقاصرين عن الارتقاء في غياب الآخر الذي يحقّق وجوده. وقد اضطلعت نظريات الاستعمار بتقديم قاعدة للقراءة، وفضح فكرة الإذعان التي لازمت المستعمِر في علاقته بالمستعمَر، وتفكيك التَّسلّط الذي لا وجود لمسوّغات تبرّره.
إنّ تخييل التّاريخ يسعى جاهداً إلى تمثيل التّجارب التّاريخية المرهونة بمحاور حسّاسة قلقة من قبيل السّيطرة والتّدجين الثّقافيين الممارسين على المستعمَر، وكذا تعرية التّواريخ المزيّفة وغيرها في التّجارب الاستعمارية وما بعد الاستعماريّة التي يُشكّل فيها المستعمَر نموذجاً للتّحويل والمسخ والانسلاخ عن الهُويّة الأصليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*باحث من المغرب
الهــوامــش
1 – Hayden White, Metahistory : the historical imagination in nineteenth-century Europe,
)United States of America :Johns Hopkins University Press, 2014(.
2 -هايدن وايت، “قيمة السردية في تمثيل الواقع”، ترجمة ثائر ديب، أسطور، العدد 11، يناير 2020(م)،
.178ص
3 – هايدن وايت، المرجع السابق، ص.179
4 – شاكر عبدالحميد، الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، سلسلة عالم المعرفة 360 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1978م) ص47 – 48 (بتصرف.)
5 – شاكر عبدالحميد، المرجع السابق، ص47 (بتصرف.)
6 – نادر كاظم، تمثيلات الآخر، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر، دار الفارس، 2004م)، ص.39 7 – تيري إيجلتون، نظرية الأدب، ترجمة ثائر ديب، (سورية: منشورات وزارة الثقافة، 1995م) ص.11
8 – نادر كاظم، مرجع سابق، ص.53
9 – هايدن وايت، مرجع سابق، ص180
وقد أشار أيضاً مترجم المقال في حاشية داخل مؤلّف (موقع الثقافة)، إلى ظهور التمثيل بما يرادف التصوير، في العصر الكلاسيكي، تحت تسمية ‘ التشابه’ التي يطلق عليها فوكو (أبستمية) حيث يختفي اللسان وتبقى اللغة، انظر حاشية:هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006م)، ص.101
10 – يتحدث بول ريكور عن الهُوية السّردية قائلًا: “كلّ أمة أو جماعة تاريخية تسرد تاريخها، أي أنّها لا تستطيع أن تتخلّص من نسج القصص حول ماضيها، ومزج الخيال بالواقع.” انظر: بول ريكور، الذّات عينها كآخر، ترجمة جورج زيناتي، ط1 (لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005م)، ص.661
11 – ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء، ترجمة بدر الدين عرووكي (بيروت: مركز الانتماء القومي، 1990م) ص.77
12 – نادر كاظم، مرجع سابق، ص.16 13 – السابق نفسه، ص.16
14 – عبداللّه إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ج1، ط1 (الإمارات: قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، 2016م)،
.58ص
15 – إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، ط4 (بيروت: دار الآداب، 2014م) ص.148
16 – هذا الطرح يعززه يانغ بحيث “أثبت الإنجاز النّظري لإدوارد سعيد، وهو خلقُ موضوعٍ للتّحليل اسمه الخطاب الكولونيالي، مجالًا من أهم مجالات البحث في السنوات الأخيرة، وأكثرها خصوبة، وقد جرى توسيع مفهوم الخطاب الكولولنيالي، الذي لا يزال بالضرورة موضوع جدل ونقاش، ليشمل أنساقاً أخرى كخطاب الأقلية.”… انظر: روبرت يانغ، أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، ترجمة أحمد محمود، ط1 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2003م)، ص.346
17 – إدوارد سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، ط1 (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006م)، ص.44
18 – توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ترجمة سعد هجرس، ط2 (طرابلس: دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، 2004م)، ص .15
19 – بوتومور، المرجع السابق، ص .24
20 – إدوارد سعيد، الاستشراق، مرجع سابق، ص.46
21 – لوسيانو كروبي، مفهوم الهيمنة عند غرامشي، ترجمة عبدالعزيز الأزدي، الملتقى، العدد1، 1977(م)،
.20ص
22 – سعيد، الثقافة، ص.16
23 – استفاد (إدوار سعيد) من أعمال حازت على الريادة، ونالت السبق في الخوض في ثنايا صور المستعمرات، من قبيل العمل الكلاسيكي الذّي أنتجه التونسي ألبرت ممّى المترجم بـ”المستعمِر والمستعمَر.” كتابٌ يعد إحدى أهم دراسات الاضطهاد الاستعماري المكتوبة على الإطلاق، بحيث يسعى إلى تشريح عقول كلّ من
المستعمِر والمستعمَر وأحوالهم النفسية. ويكشف ممّي حقائق حول الوضع الاستعماري والنضالات ذات الصلة باليوم، كما تصوّرها في ما مضى بعد زهاء ستة عقود من الآن، مع تحليل حالة الناس المستعمرين والتي ترجّح أنّ الإنسان لا تنضب أفعاله من الوحشية في علاقته بالإنسان في ظل السلطة والهيمنة. ويقول ندين غوردمير، في مقدمة عمل ألبير ممّي إنّ “ما كتبه ممّي عن العلاقة في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، صحيح تماماً في الألفية الجديدة. لم يتم إلغاء العبودية، بل تطورت إلى استعمار. لم يغير منظور الماضي، من منظور معنى ما تم فعله لإخضاع الشعوب في أراضيهم. ومع ذلك، تم نشر دراسة ممّي لأول مرة في 1957م، أي قبل أن تصبح غانا أوّل دولة محتلة استعمارياً في أفريقيا، مستقلة بعدها. لذلك فإن الكتاب يسبق تلك الأشكال الآيديولوجية التي تحققت من خلالها بالتحديد من حيث مشاركة المستعمرين اليساريين مع المستعمَرين في العديد من البلدان على مدار ستة وأربعين عاماً منذ ذلك الحين. ولقد أثبتت تنبؤات ممّي حول الأدوار المغالطة لليسار.” انظر الكتاب، ومقدمة الكتاب:
Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized, ntroduction by Jean-Paul Sartre, New Introduction
by Nadine Gordimer, Translated by Howard Greenfeld )London: Earthscan Publications,2003(, p 27 .
24 – كتابات فانون تذهب إلى أنّ الاستعمار يشوّه الذّات الإنسانية، ويؤكد أنّ الجوهر الآيديولوجي للاستعمار هو الإلغاء المُمنهج للصّفات الإنسانية للشعب المستعمَر، والتي تنتقص منه وتُدرجه في خانة الوحشية، ويتم تجريد من الإنسانية، من خلال العنف الجسدي والفكري الممارس عليه… انظر: فرانز فانون، معذبو الأرض، تصدير جون بول سارتر، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، ط2 (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر،
.)م2015
25 – David Huddart, Homi K. Bhabha, First published )Lodon and New York: Routledge, 2006(, p83.
26 – يعمل الكتاب على خلق جملة من المفاهيم الرّئيسية، بحيث يشرح “الاغتراب الثّقافي” من خلال التّحليل
النفسي لفهم الاستعمار وما بعد الاستعمار، ويتبع آثار “الهجنة الثقافية” على خطابات القومية والحقوق الثقافية، وكذا “الصّورة النمطية الثقافية” في كيفية إعادة تفسير الخطابات الاستعمارية، وإيجاد قلق مركزي لخطابات المستعمر… انظر: هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006م.)
27 – David Huddart, p1
28 -Ibid, p2
29 – ركزت دراسات فرعيّة على دراسات ما بعد الاستعمار على ما يُنتسبُ إلى Studies Subaltern “دراسات التّابع” كمشروع لإعادة النظر في التّأْريخ الاستعماري الهندي من منظور السّلسلة المتقطعة لحركات الفلاحين أثناء الاحتلال الاستعماري، وأبرز الدارسين هناك راناجيت غوها، المحرر المؤسّس للجماعة، الذي يرى أنّ تاريخ القومية الهندية كانت لفترة طويلة تهيمن عليها النخبوية القومية البرجوازية.. انظر:
Ranajit Guha, Subaltern studies, )Delhi: Oxford university press, 1982(.
وللتفصيل في تاريخ النشأة، يمكن الاطلاع على:
Chakrabarty Dipesh, Habitations of modernity : essays in the wake of subaltern studies, fore- word by Homi K. Bhabha )Chicago: The University of Chicago, 2002(, p 3-19