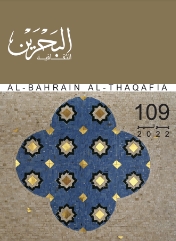قراءة في كتاب “الأثر” للورنس فريدمان
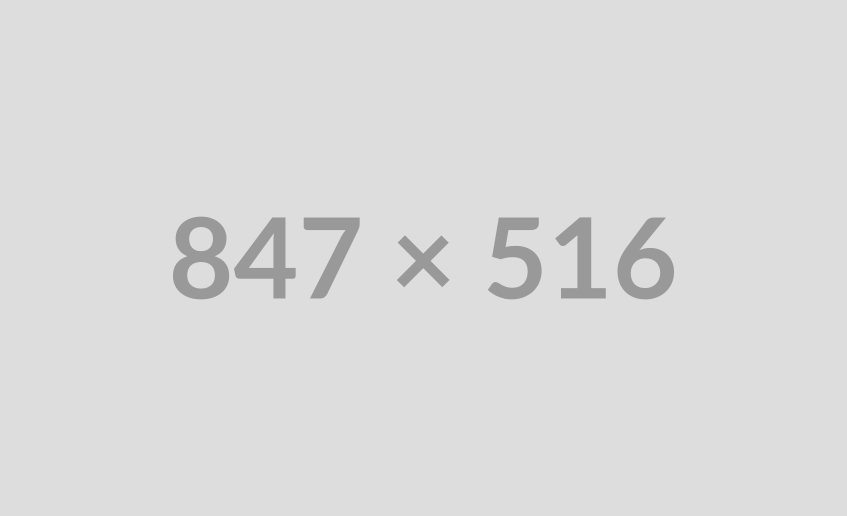
قراءة في كتاب “الأثر” للورنس فريدمان
للقوانين آثارٌ على السُّلوك وعلاقات بينية بعديد العلوم
د. علي فيصل الصديقي*
عادةً ما تتناول الدراسات القانونية، النظرية والتطبيقية، محاولة أساتذة القانون ربط الجانب القانوني لأيّ قضية محلّ الدراسة بالواقع المَعيش، وذلك عبر الاستخدام المُعتاد لفكرة البحث العلمي القانوني التي تقوم على دراسة النص القانوني، وتشخصيه في إطاره الذاتي، وتبيان حدوده العملية، وسياقاته التطبيقية، ومجالات إنفاذه، وثغراته المرصودة، وإنزال تلك الأحكام القانونية على الأحداث الواقعية. أي أن الدراسات القانونية -التي نُطلق عليها مجازاً “دراسات قانونية تقليدية“- تشبه “علم النوازل الفقهية“، تلك التي يُعرّفها علماء القانون الإسلامي بكونها معرفة الحوادث وتبيان الأحكام الشرعية الخاصة بها.
وعلى الرغم من وجود بعض الاتجاهات العلمية لدى دارسي القانون لبحث “الإطار الخارجي“ لعلم القانون، لا تزال هذه الاتجاهات في واقعنا العربي قليلة مقارنة بحجمها كماً ونوعاً لدى الفقه الغربي، وهي نادرة ندرة شديدة قياساً بتجربة البحث العلمي القانوني في “الإطار الداخلي“. ذلك أنّ الأطر الخارجية لعلم القانون تعني دراسة الأوضاع القانونية من خارج علم القانون، أو في حدوده، أو على هوامشه، وبالتالي فإن مثل هذه الدراسات تفترض تلاقح علم القانون بغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، بل ربما العلوم التطبيقية في بعض السياقات. ففي دراسات الأطر الخارجية، تقترب الحقول المعرفيّة من بعضها البعض وتتقاطع وتتفارق.
قد يبدو للوهلة الأولى للقانونيّين الكلاسيكيّين أنهم قريبون من العلوم الأخرى، وأنّ دراساتهم للنص القانوني، وتشخيصه، وتحليله، هي في حقيقتها دراسات تأخذ بعين الاعتبار الواقع والمجتمع، غير أنّ ذلك الأمر ليس على صحيحاً على إطلاقه. فعندما نتحدث عن دراسات الإطار الخارجي للقانون، فنحن نتحدث عن مقاربات ما بين التخصصات المختلفة، كالاقتصاد، وعلم الاجتماع، والفلسفة، وعلوم الاتصال، وغيرها. وفي تقديري الشخصي أنّنا –أساتذةً ومشتغلين في الحقل القانوني– ما زلنا لا نستسيغ –على نحو العموم- الدِّراسات التي تقع ما بين علم القانون وأقرانه، فلا نعتدّ كثيراً بدراسة المُتخصّص القانوني الذي يتلبّس جبّة تخصص آخر، ولا نستسيغ دراسة من غير أهل التخصّص لقضية قانونية، بحيث نعتبره متطفلاً إلى حدٍ ما. وكي لا أكون متشائماً؛ فإن هناك محاولات جادّة لتقريب علم القانون من بقية العلوم –وخاصة الاجتماعية والإنسانية الأخرى– تقودها شخصيات بارزة في الحقل القانوني العربي، ليس هنا المقام لاستعراض أعمالها.
مدخل أوّلي للكتاب
في الصفحات القليلة المقبلة، سوف أقدم عرضاً لكتاب مهمٍّ بشأن إحدى المحاولات البحثية الجادة التي صدرت مؤخراً في صلب مجال دراسات الأطر الخارجية للقانون، وهو كتاب (الأثر: كيف يؤثر القانون في السُّلوك) لمؤلفه لورانس فريدمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الأمريكية، وهو باحث متخصِّص في التاريخ القانوني، وله مؤلَّفات وأبحاث في هذا المجال. وقد نشر دراسته –التي نتحدّث عنها– ضمن منشورات جامعة هارفرد عام 2016م تحت عنوان (Impact: Haw Law Affects Behavior)، وصدرت النسخة العربية المُترجمة في مارس 2020م ضمن العدد (482) من سلسلة “عالم المعرفة“ التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت1. وقد ترجمه مصطفى ناصر، وهو صاحب اهتمامات بالترجمة، وقدم جملة من الأعمال المترجمة قبل هذا الكتاب.
أربعون عاماً بين مقالتين
يقول المؤلف لورانس فريدمان إنه نشر في عام 1975م كتاباً بعنوان (النظام القانوني: من منظور العلوم الاجتماعية The Legal System: A Social Science Perspective) وتناول فيه فصلين حول موضوع “الأثر“، وإنه قرَّر الرُّجوع إلى الموضوع بعد أربعين عاماً، وهو –في اعتقادي– ما انعكس في قدرة المؤلّف على تسخير خبراته وقراءاته في تلك السَّنوات ليوظِّفها في كتابه الماثل، خاصَّة وأنّ كثيراً من الدِّراسات خلال تلك الفترة الزَّمنية الطَّويلة قد ظهرت في الغرب –وفي أمريكا على وجه التَّـحديد– تتناول قضايا على هوامش القانون، كدراسة بعنوان “مدى قدرة المحاكم على التأثير في الواقع الاجتماعي“ لجيرالد روسنبيرغ، وأخرى بعنوان “صورة القانون في حياة الجميع“ لستيوارت ماكولي، ودراسة “القانون والعدالة كما تبدو في شاشة التلفزيون” لإيلاين رابينغ، وغيرها من دراسات وبحوث كانت حاضرة بقوة في ثبت المصادر التي استعان بها فريدمان.
الشَّاهد أنّ فريدمان حاول في كتابه الاستعانة بجملة من الموضوعات المتناثرة في بحث قضية الأثر الذي يعكسه القانون في السُّلوك، وحاول ربطها بعضها البعض ليكوِّن لنا ما يشبه نظرية عامَّة في قضية “الأثر“. ومع أنَّه لا يدَّعي السَّير نحو تقرير نظرية عامَّة؛ فإنّ دراسته كانت محاولة جديّة نحو ذلك، وإنْ لم يصرّح بها، فيقول في التَّـمهيد القصير جدّاً ما نصُّه:
“تكمُن القيمة في إظهار نوع من النِّـظام وسط الفوضى، نوع من التَّــناغم بين الأصوات المتضاربة والتَّــشويش. تكمن القيمة في توفير سلسلة خُطَّافات لتعليق كلّ الدّراسات الأكاديمية عليها. تكمن القيمة في تصنيف واقتراح بعض السِّياقات ذات المعنى الواقعي. ومن ثمَّ فإنَّ الصَّفحات اللاحقة تتضمَّن محاولتي المتواضعة للاضطلاع بكلِّ هذه الأمور المتشعّبة”.2
أهمية دراسة الأثر
يشير المؤلف في الفصل الخاصِّ بالمقدِّمة إلى ارتباط علم القانون بالدّراسات الاجتماعية عموماً، ونوّه إلى وجود تيَّــار من أساتذة القانون يرون ربط القانون بالمجتمع، وإلى وجود مؤسسات ومجلّات علمية في سبيل ذلك، رغم أنّه يعترف بوجود من أسماهم “علماء القانون المتشددين“ الذين ما زالوا يرون علم القانون مستقلاً بذاته. إنَّ المؤلِّف يفتتح كلامه بالإشارة إلى أنّ أيّ عملية استقصاء للقانون يجب أن تدرس فكرة “الأثر“ فهو يرى أنه من غير المحتمل أن نتمكَّن من تخصيص قواعد عامَّة من شأنها أن تفسّر أسباب وطرق تحقُّــق الأثر، إلّا إذا حصل ذلك على مستوى بالغ الدّقة. وهو ما يدعو –بالطَّبع– إلى دراسة القانون وفق قواعد منظور علوم اجتماعية أخرى تفرضها ضرورات عملية من خلال التحركات التي تمارسها قوى الضغط الاجتماعي في أيّ مجتمع، كتلك القوانين ذات العلاقة بالمستهلكين مثلاً، حيث إنَّ التَّــفاعل الاجتماعي بين القانون والقوى الضَّاغطة تظلُّ في حالة متَّــصلة من “الرَّقص” لا تكاد تتوقف من الفعل، وردِّ الفعل، ومزيدٍ من الفعل، وهي ظاهرة شائعة لأيِّ نظام قانوني معاصر في مجتمع متطوّر. فهناك ما أسماه “الضَّغط المرتدّ على القانون أو بعض نتائج القانون” بوصفها جزءاً من الأثر. ويذهب المؤلف إلى وجود قيمة حقيقية لعزل دراسات الأثر ووضعها تحت عدسة مكبّرة. ينهي فريدمان مقدّمته بطرح التَّـساؤلات الخاصَّة بكلِّ فصل من الفصول التي سيتحدثُّ عنها. لكننا هنا نعرض أبرز أطروحات المؤلف وفق فهمنا لمحتوياته، دون تقيّد بالتراتبية التي وضعها لخطة الكتاب.
ماهية الرسالة القانونية
إنّ كل مادّة قانونية مُدرجة في النِّظام القانوني، يُراد منها توصيل رسالة أو رسالتين على الأقل؛ الأولى إلى عامّة الناس، والأخرى إلى السُّلطات القانونية. فقانون تجريم السَّرقة –مثلاً– يتضمَّن رسالة إلى الجمهور، ورسالة إلى الشُّرطة والادعاء العامّ وهيئات المحلَّفين وحُرّاس ومديري السّجون وغيرهم. وفي بعض القوانين جانب من التعقيد في صياغتها أو حجمها، بحيث إنّ اللوائح القانونية تصدر أحياناً على شكل كتاب ضخم يتضمَّن قواعد تتألف ربَّما من آلاف الصَّفحات أو أكثر، فلا يمكن لأحد أن يجلس ويقرأ هذا الكتاب، فكيف تصل الرِّسالة إذن؟ يقول فريدمان إنّ الرسالة التي تصل إلى الجمهور ليس مصدرها تلك القوانين واللوائح، وإنما يتلقّى الجمهور معلوماته من جملة مصادر في الثقافة العامَّة التي تتضمَّن –في بعض الأحيان– معلومات خاطئة. فالنَّاس يتعلَّمون شيئاً من المدرسة، وشيئاً من الوالدين، وآخر من الأصدقاء. فالحياة عبارة عن عملية تعلُّم للقواعد، فضلاً عن البرامج التلفزيونية وأخبار المساء. الرِّسالة في نظره قد تكون مشوَّهة “بنحو خطير ومنهجي”، خاصة في ما يتعلق بالجرائم، وإطلاق سراح المتَّـهمين لوجود أخطاء إجرائية معيَّـنة. ومن جانب آخر، فإن الرسالة التي تصل إلى الجمهور ضمنيّاً أنّ الجريمة عموماً منتشرة في كل مكان، ويتعرض الناس لكمٍ هائلٍ من المعلومات ورسائل القانون بشيء من التَّـشويه.
هنا يستعرض فريدمان الدِّراسات التي تمَّـت في هذا الصَّدد، كما في الأفلام وشاشات التلفزيون، ثم يتعرَّض إلى البرامج التلفزيونية كبرنامج (القاضية جودي Judge Judy) التي تبتعد عن واقع القضاء في بعض الأحيان. ويقول إن وسائل الإعلام –عندما تتدخَّل– فإنها أحياناً تسيء للنظام القانوني والقضائي، كما في بعض القصص التي يربح فيها أحد الخصوم حكماً عبثيّاً. يقول إنّ من السُّهولة بمكان إيجاد دليل على أنَّ وسائل الإعلام تمارس دوراً تشويشيّاً، ولكن النتائج المستخلصة من الأثر الفعلي في السُّلوك يصعب جمعها، ومن باب أولى يصعب جمع نتائج تأثير الإنترنت وشبكات التَّـواصل الاجتماعي.
إنّ وصول الرَّسائل إلى الجمهور قد يكون مباشراً أو غير مباشر. وأفكار الناس حول القوانين مختصَرة جدّاً. فعندما حاول باحثون قياس المعرفة القانونية عند النَّاس، وجدوا أن نسبة الجهل تعلو نسبة المعرفة، ويضرب مثالاً في أحد القوانين المناهضة للتمييز الصَّادرة في ألمانيا عام 2006م قائلاً:
“في استفتاء أجري بعد سنتين، اتَّـضح أنَّ نحو ثلث العيّنة من النَّاس سمعوا بذلك القانون، خمسة عشر بالمائة منهم ربما سمعوا به، ولكنهم ليسوا متأكدين. هذا –بطبيعة الحال– لا يخبرنا عمّا إذا كان النّاس الذين سمعوا بالقانون يعرفون شيئاً عن المضمون”.3
وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الأحكام القضائية، فلها رسالتان؛ الأولى تتضمن ما قاله القضاة بالضَّبط، والأخرى تتمثل في خلاصة النَّتيجة، وهو ما تسعى الصُّحف إلى تلقُّـفه، فهم يريدون معرفة “من الرَّابح” في القضية بكل بساطة؟
يضيف فريدمان أن هناك “سماسرة معلومات” يقومون بمساندة النّـظام القانوني. فقانون الضَّريبة في الولايات المتحدة يتألَّـف من آلاف الصَّفحات، مكتوب بأسلوبٍ ركيكٍ غير قابل للفهم، لا يكاد يمتُّ للإنجليزية بصِلة، ولكن يُفترض بالنّاس دفع الضَّريبة في وقتها. يقوم سماسرة المعلومات –وهم غالباً المحامون- بنقل تلك الرّسالة من صيغتها المعقَّـدة إلى تبسيطها وتوضيحها وإيجاد السُّبل الكفيلة بتنفيذ القانون وتحقيق متطلّباته دون مساءلة. فهم يؤدُّون دور “الوساطة” أو “العميل المزدوج” للدَّولة ودافع الضريبة، أي يخدم الدَّولة في التَّحصيل، كما يخدم دافع الضَّريبة في تسوية أوضاعه القانونية. وقد يقوم بهذه المهام كُتّاب العدل وكُتّاب العرائض، وبعض الخبراء في مجالات محدَّدة في القانون.
قياس الأثر
الأثر –وفقاً لفريدمان– حياديُّ المعنى، يتطرّق إلى التغيّرات التي تحصل بعد، وبسبب، بعض النَّـشاطات ضمن النّـظام القانوني، ويقسّم الأثر إلى نوعين: أثر مباشر وآخر غير مباشر، ويظهر الأثر المباشر بصورة أوضح. ففي قياس التَّـأثير المباشر، فإنَّ التّـدخُّل التَّـشريعي البسيط والحادّ والمحدَّد، يمكن أن يُقاس بطريقة سهلة، كقياس أثر تطبيق حساب الضَّريبة. ولكن الأثر غير المباشر يسمّيه “التّـأثير الموجي“ للمواد القانونية. فالتَّـأثيرات الموجية يمكن أن تضيف إلى أثر القانون جوانب سلبية، تماماً كما يفعل الدَّواء في تأثيراته الجانبية. بَيدَ أنّ قياس التَّـأثيرات الإيجابية والسَّلبية عملية صعبة ومعقَّدة. فصدور قانون معيَّن يولِّد فعلاً وردّة فعل، وهذا الارتداد، “أو التأثيرات الجانبية” تستحقّ البحث، أي تستحقّ أكثر من مجرّد نظرة عابرة، خاصة وأن هنالك نظرية أخرى تقول إنَّ للأثر نتائج فوريّة ونتائج طويلة الأجل في ما يتعلق بالارتداد. وفي الفقه القانوني، يقول فريدمان إن هناك عدداً هائلاً من الدّراسات القانونية (وهي أكثر مما ينبغي وفق رأيه) تهتمُّ بالأثر الدَّاخلي البحت للقانون، وتتجاهل الأثر الخارجي. فالأثر القانوني (أو الأثر المُفترض) هو ما يدرسه الطلبة في كليات الحقوق، غير أنَّ هناك تأثيرات موجية للقرارات في سياقات أخرى.
ولا يحصل التَّدخُّل القانوني في فراغ، بل ينشأ في فضاء اجتماعي مزدحم بالنَّشاط الموجود سلفاً، وما يتضمَّنه ذلك الفضاء هو الذي يحدِّد طبيعة استجابة المخاطَبين لأحكام القانون، ومن ذلك تتأثّر الاستجابة إلى مدى وجود قيم دينية ومعتقدات راسخة وأخلاقيات عميقة. قد يتولَّد عن القانون منظومات مزدَوَجة: بمعنى أنّ القانون الذي في الكتب والقانون المطبَّق غير متماثليْن. أحياناً يكون الاختلاف بينهما كبيراً جدّاً إلى درجة يمكننا وصفهما بأنَّهما نظامان متمايزان. يمثّــل القانون الرَّسمي، أو يبدو أنه يمثِّــل، الأسس الأخلاقية المُثلى. أمَّا الجانب الآخر للقانون، فإنّه الرَّابح على مستوى التَّـطبيق الفعلي. أحياناً يُضطرُّ المخاطَبون إلى “تعديل سلوكهم” مع مقتضيات القانون. يقول فريدمان:
“النَّاس ليسوا بالمكائن أو الرُّوبوتات. سلوك الناس، ردَّاً على القانون في الغالب (وليس دائماً)، لابدَّ أن يأتي بشكل أو بآخر بحرّية”.4
تقوم عملية قياس الأثر، وفقاً لفريدمان، على ثلاثة عوامل هي:
1/ الثواب والعقاب: حيث يرى أنَّ الاستجابة للقوانين إنّما يحكمها –كعنصر أول– فكرة الرَّدع الشَّهيرة في القانون، وناقش فيها مدى جدوى فكرة الرّدع، وتوصَّل إلى أنَّها تتعلّق بما أطلق عليه “منحنى الرَّدع”. فالرَّدع لديه يتفاوت من قانون إلى آخر، تقاس فاعليته من خلال عملية الاستجابة. ثم ناقش مدى الرَّدع الذي تحقّـقه عقوبة الإعدام، وكيفية تعامل المجرمين مع فكرة الرَّدع، وتأثيرها في الدوافع الإجراميّة، وذكّر بوجود فرقٍ بين ما يُطلق عليه “القوانين التَّعبيرية والقوانين الأداتية“، وأنّ أكثر من يدفع بفكرة الرَّدع –بوصفها نموذجاً يجب تطبيقه– هم الاقتصاديون. ثم يتحدث فريدمان عن فكرة الثَّـواب والعقاب في الجانب المدني الذي ينطوي على ما أسماه بالمحفِّــزات للامتثال للقانون، والمكافآت التي تقدّمها معظم النُّظم القانونية للأفراد الذين يقدمون شكاوى ضدَّ الشَّركات أو الحكومة في مجال الإبلاغ عن الجرائم، ويقول بأنَّ أيّ نظام قانوني حديث يجب أن يكون معقَّـداً في وضع قائمة “العصا والجزرة”، ضارباً على ذلك مثالاً في قانون الضَّريبة الذي يتضمَّن مخالفات وثغرات واستثناءات، واستثناءات على الاستثناءات، فضلاً عن قواعد إيجابية متمثّلة في قوانين أخرى، كأنظمة التَّــقاعد، وبدلات العاطلين عن العمل، وغيرها. يقول فريدمان:
“النّـظام القانوني مملوءٌ بمثل هذه المخارج الملتوية: أي الإجراءات والوسائل التي تُجبر على الالتزام أو تجعل المخالفة أكثر صعوبة. النّـظام القسري لقانون الضَّـريبة عبارة عن بعض المخارج الملتوية والمؤثرة”5.
2/ ضغط الأقران: يقول فريدمان إنّ سياسات الثّـواب والعقاب تفسِّر جزءاً كبيراً من عملية الامتثال للقانون، ولكنّها لا تفسّر كلَّ شيء. فما الذي يدفع النَّـاس لدفع الضَّرائب؟ سؤال محيّر من وجهة نظر بعض الاقتصاديين. إنَّ التّجانس الثَّــقافي في المجتمعات، يجعل لهذه الثَّــقافات معاييرها وأشكالها التي تتمثَّـل في ضغط الأقران في ذلك المجتمع، أي ضغط الثقافة الفرعية. فالعائلات أكبر أنواع الأقران ضغطاً، متمثّـلة في قوّة الوالدين، والإخوة، والأخوات، والأزواج، والشُّركاء. بل يشير إلى أن “وصمة العار” تعتبر مؤشّراً أو علامة خارجية تلاحق الشَّخص الذي يخرق لائحةً أو معياراً ما، أي الخجل والإحساس بالذَّنب والإحراج. وصمة العار هذه عقوبة قوية، والخجل له تأثير كبير في السُّلوك، بل هي أفضل السُّبل ضمن ظروف اجتماعية محدَّدة. ويضرب في استخدام بعض النُّظم القانونية لعنصر الخجل مثالاً، كوضع لوحات على سيارات السُّكارى بلون أصفر برّاق طبقاً لقانون إصلاح المرور في أوهايو. ويضيف بقوله:
“لا تزال عقوبة وصمة العار والخجل هي من الأسلحة الفعَّـالة. إنّها –على وجه التحديد– فعَّـالة في هذه الأيّام؛ في زمن وسائل الإعلام الواسعة الانتشار، وشبكات التَّـواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل“6.
ثم يتحدَّث عن مصطلح “العدالة التقويمية” الذي أصبح يُثار أكاديميّاً، باعتباره وجهاً للحرص على التَّـماسك الاجتماعي، وتفادي تفكيك الرَّوابط، ومعالجة تمزيق النَّسيج الاجتماعي، وإرجاع التَّـوازن والاتّساق، في مجتمعات يؤدِّي فيها ضغط الأقران دوراً في حلِّ النّـزاعات. يضيف مثلاً يتعلّق بتجّار الألماس الذين تتشكَّل لديهم معايير جماعية، فتبقى المنازعات وحلّها في إطار العائلة، حين يصرُّ اليهود الأرثوذوكس على أنَّ النّـزاعات يجب أن تُحسم في “الدَّاخل”، فبذلك يوجِدون الآلية المناسبة لحلّها حتى لا تتمّ خسارة الرَّوابط الاجتماعية.
3/ الصَّوت الدَّاخلي: عاملٌ صعبٌ ومُعقَّد، حقيبة تضمُّ أفكاراً ومواقف متنوّعة ومسائل أخلاقية، وهو ما يُطلق عليه أحياناً “الضَّمير”. فأحياناً، لا الثَّــواب والعقاب، ولا ضغط الأقران يشكّل عاملاً في الاستجابة للقانون، بل تكمن الاستجابة في سلوك ينحو نحو الالتزام. يقول المؤلّف إنّ فكرة “الشَّرعية” تجد أساساً لعملية الاستجابة، على الأقل وفقاً لما ذكره عالم الاجتماع القانوني ماكس فيبر، الذي فرَّق بين سلطة الكاريزما التي يملكها الأب، أو الإله، أو البطل، والسُّلطة التقليدية التي يملكها كبار السّن، وزعماء القبائل، والقادة، وسلطة ثالثة هي السُّلطة الشّرعية العقلانية التي تفيد طاعة القانون لمجرد أنّها قوانين توضع بوعي وعن قصد، حيث تخلق لدى النّاس استعداداً شاملاً لقبول القرارات حتى قبل صدورها، وهي عنصر إجرائيٌّ مهمٌّ في الاستجابة للقانون. ثم يقول إن “الانتخابات الديمقراطية” تشكّل عاملاً قويّاً في إضفاء الشَّرعية. ويقول إن جوهر الشَّرعية:
“في المجتمع نوعٌ من الطَّاعة يأتي من احترام السُّلطة، بدل الخوف من العقوبة، أو تأتي من الشُّعور بأنَّ اللوائح التي نتكلّم عنها هي الشَّيء الصَّحيح الذي ينبغي أن نفعله، أخلاقياً واجتماعياً“7.
يضيف فريدمان أنّ هناك دوافع أخرى ضمن هذه المجموعة، وهي أنَّ النَّاس يطيعون القوانين بسبب أنها قوانين أخلاقية، أو منسجمة مع الأعراف، ربما تعبّر عن إرادة إلهية. فقد تؤدّي المعتقدات الدّينية، والأعراف، وحتى الخرافات، دوراً كبيراً في تحديد أثر القانون. ثم يناقش مدلولات “الثَّــقافة القانونية”، و”الوعي القانوني”، وعدداً من الدّراسات التي تطرَّقت إلى ذلك. وينتهي إلى القول:
“القانون من العوامل التي تجعل الناس يقبلون العالم كما هو عليه. بهذه الطّريقة، بصورة غير مباشرة، القانون له أثر، لكن بنحو سلس وبلا وعي. إذن السُّلوك الذي يأتي بلا تفكير جزء من آثار موجات القانون…”8.
ينتهي فريدمان إلى أنَّ المجموعات الثلاث هي التي تحدِّد الأثر القانوني، وأنّ علماء الاقتصاد ينظرون إلى كلِّ شيء من منطق التَّكاليف والمنافع، فيحبّون نظرية الرَّدع. ولكن العوامل الثلاثة لها دورها جميعاً، وقد تتضارب بعضها البعض. فقد تكون العوامل الأخلاقية أقوى من المحفّزات أو العقوبات. فإذا وضعت ثمناً للسُّلوك، فأنت تنقل موقفاً ذا طبيعة اجتماعية إلى الإطار المالي.
كما أنَّ مجموعة الدَّوافع هذه تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، كما أنّ الظُّروف تؤثّر في طاعة القانون من قبل النّاس، أو في تعديل سلوكهم مع مقتضيات القانون. كما أنّ الثَّــقافة تُحدث فارقاً في آليات الاستجابة. فأثر القانون في حقيقته “عملية ديناميكية. النّظام القانوني يتغيَّر بتغيُّر المجتمعات، والأثر يتغيَّر أيضاً، يمكن أن يتصاعد وينخفض“9.
ملاحظات وتعقيبات
- انطوت الدّراسة، نوعاً ما، على تحليل مركّز للأثر المتعلق بالتَّـشريعات العقابية (بمعناها الواسع)، حيث كان القانون العقابي حاضراً بصورة أكبر في الدّراسة من فكرة الأثر في سياقاتها المدنية، أو الدستورية، أو الإدارية، أو الدولي الخاص، بل حتَّى عندما ضرب أمثلة كثيرة على قانون الضريبة كان قد أعطى الجانب العقابي (التَّــهرُّب الضَّريبي) حضوراً في دراسته، ولعلَّ ذلك راجع إلى سهولة قياس فعَّالية فكرة الأثر ووضوح التَّـأثيرات على سلوك المخاطَبين في القوانين العقابية، أو شبه العقابية. غير أن ملاحظتنا هذه لا تقلل من قيمة العمل الذي قدمه فريدمان، بل إنَّها مشجّعة ومحفّـزة لمزيدٍ من دراسات الأثر وفق كل تخصُّص ومجال، أي تحفّزنا لندرس نظرية الأثر في كلّ فرعٍ من فروع القانون. وهو ما ندعو فقهنا العربي إلى البحث فيه.
- اتَّخذت دراسة فريدمان بُعداً شمولياً في علم القانون، أو علم الاجتماع المرتبط بعلم القانون جملةً. ففي اعتقادي أنّ ما يُحفّز الاستجابة لقواعد القانون الدُّستوري عوامل تختلف عن تلك المؤدّية للاستجابة للقانون الجنائي، وهي تختلف بالضَّرورة عن العوامل المؤدّية للقانون المدني أو التّجاري. لذلك فإنّ دراسة الأثر في كل فرع من فروع القانون –على حدة- قد يؤدّي إلى نتائج أكثر نجاعة من دراسته دراسة شمولية، بسبب حجم التَّعقيدات، وتفرُّع السّياقات التي يطلب تنفيذها كلُّ قانون. وإنّ الدّراسات الشمولية قد لا تؤدّي إلى نتائج واقعية، وهو ما وقع فيه فريدمان، رغم محاولته التي تستَّحق الإشادة.
- استخدم لورانس فريدمان عدداً من المراجع والمصادر كانت جيّدة وقيّمة، وكانت الإحالات إلى الهوامش متنوّعة، وتتضمّن –في أحيانٍ– معلومات تسند المتن، وهذا يدلُّ على سعة اطلاع سبق تأليف الكتاب.
- كان المترجم مصطفى ناصر، موفّـقاً جدّاً في اختيار مصطلحاته وعباراته، وقد عكست التَّرجمة روح النَّص الأصلي، كما أنَّــها مبسَّطة للقارئ بشكل يحفّزه على استيعاب الفكرة، فقد استطاع المترجم نقل المعنى القانوني بيسرٍ، رغم عدم تخصُّصه في حقل القانون.
- مثل هذه الدراسات يمكن أن تكون في صميم البرامج الأكاديمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لأننا عادةً –في دراساتنا القانونية– نضع علم القانون مستقلاً بذاته، ولا نضعه في إطاره “البيني” المرتبط بتعدُّد العلوم والحقول المعرفية والرَّبط فيما بينها. فمثل هذه الدّراسات تتجاوز النَّظرة الشّرُوحيّة الوصفيّة للقانون التي ترتكز على أطُره الدَّاخلية، نحو تَشخيص مشاكل القانون وآثاره الاجتماعية، وقليلةٌ هي الدراسات –في واقعنا العربي- التي تحاول قياس الأثر الاجتماعي للقانون، وترجع قلّتها إلى أنَّ مثل هذه المناقشة ليست مطلوبة كثيراً في علم القانون، لكونها تتحسّس أُطراً خارجية للقانون من جانب، ولغلبة الاتجاهات والسّياسات والآيديولوجيات العامّة وهيمنتها على العلم القانوني من جانب آخر. ولهذا تجد أنّ الدَّراسات المتعلّقة بالتَّحليل الاقتصادي للقانون، ودراسة المشاكل الاقتصادية، حظيت مؤخراً –في الفقه القانوني العربي– باهتمام لا بأس به، بيد أنّ إهمالاً ملموساً طال التَّحليل الاجتماعي للقانون وأثره في سلوك الأفراد والجماعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب من مملكة البحرين